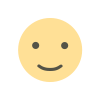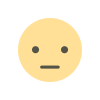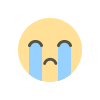باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها 3
بطاقات دعوية
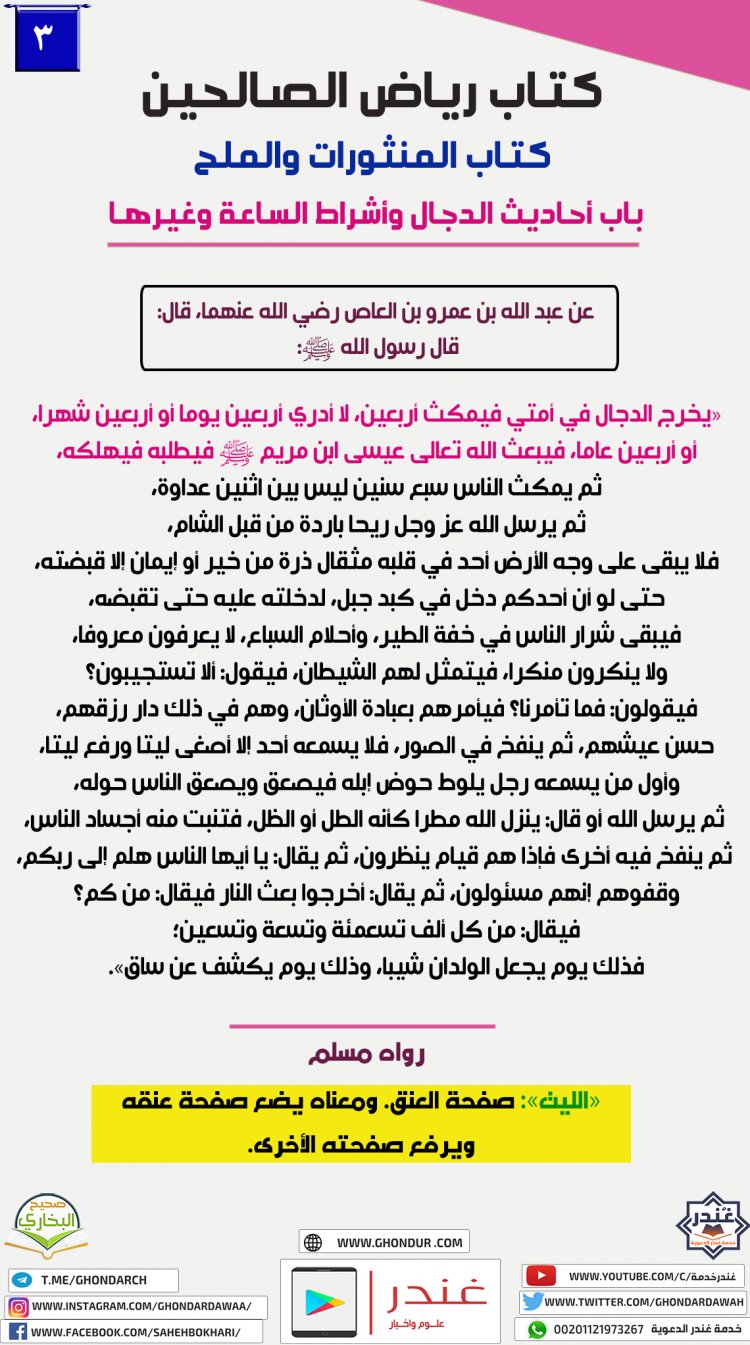
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا، أو أربعين عاما، فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله - عز وجل - ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان، فيقول: [ص:506] ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط (1) حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله، ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسئولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين؛ فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق». رواه مسلم. (2)
«الليت»: صفحة العنق. ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى.

بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة وما يحدث من شدائد قبلها، وفصلها وبين أحوالها وكيف ينجو الناس من الفتن التي تسبق القيامة، ووجه المسلمين إلى عمل الطاعات استعدادا للساعة
وفي هذا الحديث يروي التابعي يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي أنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: «ما هذا الحديث الذي تحدث به؟! تقول: إن الساعة» وهي يوم القيامة، «تقوم إلى كذا وكذا!» يحدثه بالحديث الذي سمعه عنه، وكأن الرجل يستنكر ما جاء فيه، فقال عبد الله رضي الله عنه للرجل: «سبحان الله! أو لا إله إلا الله! أو كلمة نحوهما» أي: قريبة منهما، وقد قال عبد الله هذه الكلمة تعجبا من مراجعة الرجل له في الحديث وما جاء فيه من أخبار، أو أن الذي قاله الرجل من حديث منسوب لعبد الله فيه مخالفة لصحيح حديث عبد الله رضي الله عنه الذي حدث به، ثم قال عبد الله رضي الله عنه «لقد هممت»، أي: عزمت في نفسي على «ألا أحدث أحدا شيئا أبدا» أي: أن يمتنع عن ذكر الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من كتم العلم ومنعه، ثم جعل رضي الله عنه يحدثهم بالحديث على وجهه الصحيح، فقال: «إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل» من الزمن «أمرا عظيما» يدل على قرب الساعة؛ فمنه أنه «يحرق البيت» الحرام، وقد وقع ذلك في عهد ولاية عبد الله بن الزبير؛ وذلك أن يزيد بن معاوية وجه من الشام مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم لقتال ابن الزبير، فنزل بالمدينة، وقاتل أهلها في وقعة الحرة، وهزمهم وأباح المدينة ثلاثة أيام، ثم سار إلى مكة فمات بقديد، وولي الجيش الحصين بن نمير وأكمل المسير إلى مكة، فحاصر ابن الزبير وأحرقت الكعبة حتى انهدم جدارها وسقط سقفها، وكان عبد لله بن عمرو إذ ذاك حيا، وروي أنه توفي أيام تلك الفتنة، وقوله: «ويكون ويكون» من الفتن الواقعة بين المسلمين، يعني كنت ذكرت أشياء أخرى من الفتن التي ستقع قبل قيام الساعة
ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج الدجال» مأخوذ من الدجل وهو الكذب، والدجال: شخص من بني آدم ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره، ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت؛ فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا، «فيمكث أربعين» قال عبد الله بن عمرو: «لا أدري» أي: لا أعلم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعين يوما أو شهرا أو عاما»، وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: «أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم»، فيبقيه الله سبحانه تلك المدة حتى يبعث عيسى ابن مريم، فينزله من السماء حاكما بشريعة الإسلام، كما ورد في الروايات، وعيسى عليه السلام يشبه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، كان أحد الأكابر من قومه، وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية، فيطلب ويتوجه عيسى عليه السلام إلى الدجال «فيهلكه» أي: يقتله بحربة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»، فيهلك الله في زمانه الملل كلها، إلا الإسلام.
ثم بعد قتله الدجال يمكث عيسى عليه السلام بين الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة؛ وذلك لقوة الإيمان والأمانة والرخاء في الأموال، وفي تمام رواية أبي هريرة عند أحمد: «ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، لا تضرهم».
ثم بعد مرور هذه السنوات، يرسل الله ريحا باردة من جهة الشأم، والشام الآن يشمل: سورية، والأردن، وفلسطين، ولبنان، فتقبض تلك الريح روح كل مؤمن بالله عز وجل، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدا دخل في «كبد جبل»، أي: في وسطه وجوفه لدخلته عليه تلك الريح، فتكون سببا في قبض روحه وموته. فيبقى على الأرض بعد موت كل مؤمن بتلك الريح «شرار الناس» وهم خبثاؤهم ورذائلهم، فإنهم يبقون على حال يشبه «خفة الطير»، أي: اضطرابها ونفورها وسرعتها، «وأحلام السباع»، أي: في عقول السباع الناقصة، ومعنى ذلك أنهم يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كسرعة طيران الطير، ويكونون في حالة كونهم في المعاداة وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية بعضها على بعض، فهم «لا يعرفون معروفا» أي: لا يمتثلون به، فضلا عن أن يأتمروا به فيما بينهم، والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى، والإحسان إلى الناس.
«ولا ينكرون منكرا» أي: لا يجتنبون منهيا من مناهي الشرع، فضلا عن أن يتناهوا عنه فيما بينهم، والمنكر: هو كل ما قبح من الأفعال والأقوال وأدى إلى معصية الله عز وجل، وهو اسم شامل لجميع أبواب الشر، «فيتمثل لهم الشيطان»، أي: يتصور لهم بصورة إنسان، «فيقول: ألا تستجيبون؟» أي: ألا تطيعوني فيما آمركم به، قيل: وقع في بعض النسخ لمسلم -وقد رجحه البعض-: «ألا تستحيون» ومعناه: ألا تستحيون مني في ترك ما آمركم به؟ فيقولون: «فما تأمرنا؟» أي: بأي شيء تأمرنا لنطيعك فيه؟ فيأمرهم الشيطان حينئذ بعبادة «الأوثان» جمع وثن، وهو: كل ما له جثة، متخذ من نحو الحجارة والخشب؛ كصورة الآدمي. «وهم في ذلك» أي: والحال أنهم فيما ذكر من الأوصاف الرديئة والعبادات الوثنية «دار»، أي: نازل عليهم «رزقهم» بكثرة كدرور الضرع اللبن غير المنقطع والسماء بالمطر الغزير، «حسن عيشهم» فهم في سعة في معاشهم من مطعم ومشرب وملبس وعافية.
«ثم ينفخ في الصور» على أولئك الشرار النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق والإماتة، والصور: قرن ينفخ فيه، والنافخ هو ملك من الملائكة، واسمه إسرافيل عليه السلام، «فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا»، والمراد: أن كل من يسمع نفخة الصور، فإنه يصغي جانبا من عنقه للسقوط على الأرض، ويرفع الجانب الآخر لاستماع النفخة، وهو كناية عن سقوط رأسه على أحد الشقين بسبب الصعقة التي تأخذه عند ذلك، فلا تمهله، «وأول من يسمعه رجل يلوط»، أي: يطين ويصلح «حوض إبله» بالطين حتى لا يتسرب الماء، وينظفه من الغثاء ليسقي الإبل الماء، «فيصعق»، أي: يموت هو أولا «ويصعق الناس» كلهم معه، «ثم» بعدما يموت الناس كلهم «يرسل الله مطرا كأنه الطل»، وهو ما ينزل في آخر الليل من الرطوبة، وقوله: «أو الظل» شك من الراوي وليس صوابا، والأرجح ما تقدم، «فتنبت» بسببه «أجساد الناس» النخرة في قبورهم، ثم بعد ذلك المطر ينفخ في الصور مرة أخرى، وهي نفخة البعث والنشور، فإذا الناس قيام من قبورهم، فينظر بعضهم إلى بعض، ثم يقال لهم: «يا أيها الناس، هلم»، أي: تعالوا أقبلوا أو ارجعوا وأسرعوا إلى ربكم، ويقال للملائكة: «وقفوهم» أوقفوا الناس في موقف القيامة واحبسوهم فيه، «إنهم مسؤولون» عن أعمالهم خيرا أو شرا؛ ليجازوا عليها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم يقال: أخرجوا»، أي: ميزوا بين الخلائق وافصلوا بين أهل الموقف «بعث النار»، أي: من يبعث إليها ويعذب فيها، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن هذا القول يخاطب به آدم عليه السلام، ولفظه: «يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟» فيقال: «من كم؟» أي: يسأل المخاطبون عن العدد المبعوث إلى النار، «فيقال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين»، وهذا من جميع ذرية آدم عليه السلام بما فيهم يأجوج ومأجوج، فيكون من كل ألف واحد يدخل الجنة، وقد جاء في روايات أخرى في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن ذلك كبر على الصحابة وعظم عليهم، وقالوا: أينا ذلك الواحد؟! فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا؛ فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج؛ منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج ألف، فاستبشر الصحابة بذلك.
وفي هذا الوقت يصير فيه الصبيان «شيبا»، أي: يبيض شعرهم من هول الموقف، «وذلك اليوم هو «يوم يكشف عن ساق»، فيكشف الله فيه عن ساقه ويتجلى لعباده ويكشف الحجاب بينه وبينهم، وساق الله صفة ثابتة له تعالى نثبتها ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا».
وفي الحديث: بيان أحوال الدار الآخرة.
وفيه: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات.
وفيه: علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
وفيه: بيان فتنة الدجال.

 غندر
غندر