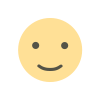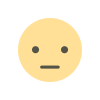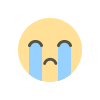باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها 1
بطاقات دعوية

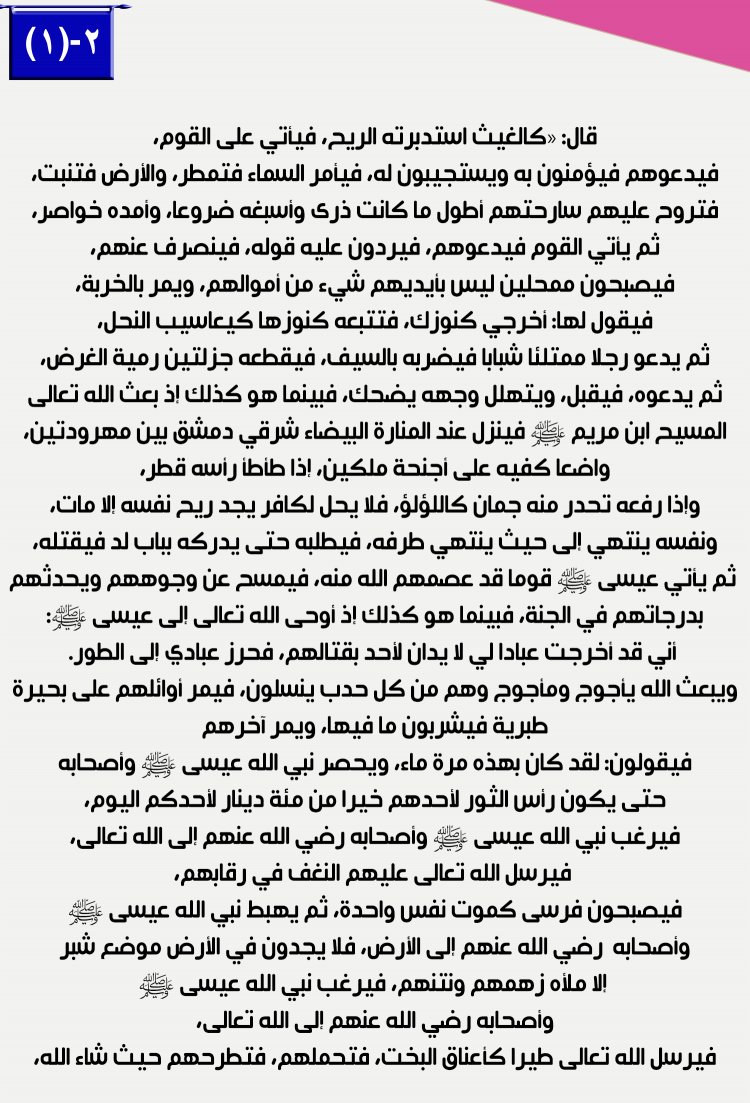

عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه، عرف ذلك فينا، فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية (2)، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف (3)؛ إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم، فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه، فيقبل، ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد (1) فيقتله، ثم يأتي عيسى - صلى الله عليه وسلم - قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى - صلى الله عليه وسلم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله - عز وجل - مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس؛ واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس؛ فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة». رواه مسلم. (1)
قوله: «خلة بين الشام والعراق»: أي طريقا بينهما. وقوله: «عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة، والعيث: أشد الفساد. «والذرى»: بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسنمة وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها «واليعاسيب»: ذكور النحل. «وجزلتين»: أي قطعتين، «والغرض»: الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب، أي: يرميه رمية كرمية النشاب إلى الهدف. «والمهرودة» بالدال المهملة والمعجمة، وهي: الثوب المصبوغ. قوله: «لا يدان»: أي لا طاقة. «والنغف»: دود. «وفرسى»: جمع فريس، وهو القتيل. و «الزلقة»: بفتح الزاي واللام وبالقاف، وروي: الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وهي المرآة. «والعصابة»: الجماعة. «والرسل» بكسر الراء: اللبن. «واللقحة»: اللبون. «والفئام» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: الجماعة. «والفخذ» من الناس: دون القبيلة.

أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، التي لن تقوم القيامة إلا بعد وقوعها، والفرق بين العلامات الصغرى والكبرى: أن الكبرى تكون أقرب لقيام الساعة، وعددها قليل، ومتتالية، ولم يقع شيء منها حتى الآن، أما الصغرى فهي كثيرة ومتباعدة، ووقع كثير منها
وفي هذا الحديث يروي النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «ذكر الدجال» الذي يظهر آخر الزمان ويكون من علامات الساعة الكبرى، وهو مأخوذ من الدجل، وهو الكذب، وهو شخص من بني آدم، يدعي الألوهية، ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، وهو من أعظم الفتن التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وفصل فيها، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه «ذات غداة»، والغداة: وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يخفض صوته مرة؛ لطول الكلام، ويرفع صوته مرة لتبليغ وإسماع من بعد، ويحتمل أن الخفض والرفع لمقام الدجال وفتنته؛ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحقره في شخصه، ويرفع من قدر فتنته وعظم أثرها في الناس، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المسيح الدجال ظهر واقترب حتى إنه في «طائفة النخل» يريد مجتمع النخل القريب منهم آنذاك؛ فلذلك خافوا منه خوفا شديدا، فلما رجع الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم في الرواح -وهو وقت آخر النهار- عرف صلى الله عليه وسلم ذلك الخوف فيهم، فسألهم صلى الله عليه وسلم: «ما شأنكم؟» أي: سبب ذلك الخوف؟ فذكروا له حالهم وخوفهم من الدجال وخروجه وفتنته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «غير الدجال أخوفني عليكم»، أي: إني أخاف عليكم من الفتن الأخرى أكثر من خوفي عليكم من فتنة الدجال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم»، أي: فأنا خصمه الذي يقيم عليه الحجة، ومقصده صلى الله عليه وسلم: أنه صلى الله عليه وسلم يمنع عنهم شره وفتنته ووصوله إليهم، «وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه»، أي: فليتول كل امرئ شأنه وبما يحفظ به نفسه من شر الدجال، «والله خليفتي على كل مسلم»، أي: الله ولي كل مسلم وحافظه، فيعينه عليه ويدفع شره، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تفويض إلى الله في كفاية كل مسلم من تلك الفتنة العظيمة وتوكل عليه في ذلك، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يبين صفة الدجال وأنه رجل شاب لا كهل ولا شيخ، «قطط»، أي: شديد القصر، وقيل: شديد جعودة الشعر، «عينه طافئة»، أي: منطفئة الضوء والنور لا ترى شيئا، وهذا في إحدى عينيه، كما في الصحيحين: «ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية»، ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» وهو رجل من خزاعة مات في الجاهلية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الدجال في زمنه «فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» وفي رواية أبي داود: «فإنها جواركم من فتنته»، بمعنى أن هذه الآيات تؤمن صاحبها من الدجال، وفي حديث أبي الدرداء عند مسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق»، أي: خارج في الطريق بين هاتين الجهتين، والشام الآن تشمل: سورية، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والخلة: موضع صخور، «فعاث يمينا وعاث شمالا» وهو الإسراع والشدة في الفساد، والمراد: يبعث سراياه يمينا وشمالا، ولا يكتفي بالإفساد فيما يطؤه من البلاد ولا يخلو من فتنته موطن، «يا عباد الله، فاثبتوا» يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمؤمنين بالثبات على الدين ولا يخشوا إلا الله، وهذا منه صلى الله عليه وسلم استمالة لقلوب أمته، وتثبيت لهم على الإيمان بالله تعالى، وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة مكثه في الأرض، فأجابهم صلى الله عليه وسلم: «أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة» أي: كأسبوع، «وسائر أيامه كأيامكم»، أي: إن باقي أيامه بعد ذلك يكون قدرها كقدر أيامكم، فسألوا: «يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة» في الطول، «أتكفينا فيه صلاة يوم؟» واحد، وهي خمس صلوات فقط، «قال: لا» أي: لا تكفيكم فيه صلاة يوم، بل «اقدروا له قدره» ومعناه: أن امتداد ذلك اليوم بهذا القدر من الطول يكون حقيقيا، لا أن الناس يظنونه كذلك لأجل ما هم فيه من الهم والغم وعليه فإنهم يصلون في قدر كل يوم وليلة خمس صلوات؛ فتجتمع في ذلك اليوم الواحد صلاة سنة كاملة، ويقاس على ذلك اليوم الذي يظل فيه شهرا، واليوم الذي يظل فيه أسبوعا.
ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم: «يا رسول الله، وما إسراعه؟» أي: ما سرعة سيره في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «كالغيث» والمراد به: الغيم، أي: يسرع في الأرض إسراع الغيم «استدبرته الريح»، أي: الذي جاءته الريح من خلفه، وهو كناية عن سرعته الشديدة والتي تجعله يطوف الأرض في أيام قليلة.
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي ويمر على القوم فيدعوهم إلى الإيمان به وتصديق ألوهيته، فيؤمنون به ويستجيبون له في جميع ما أمرهم به، فيأمر الدجال السماء أن تمطر لهم، فتمطر بأمر الله فتنة لهم، ويأمر الأرض أن تنبت لهم، فتنبت نباتا حسنا تأكله مواشيهم التي تسرح وتذهب أول النهار إلى المرعى وترجع آخر النهار، وقوله: «سارحتهم» هي المواشي التي تخرج للسرح، وهو الرعي، كالإبل والبقر والغنم، «أطول ما كانت ذرا»، أي: أسنمة وهي لحمة تنبت في وسط ظهر الإبل، «وأسبغه»، أي: أكمله وأتمه «ضروعا» وهو كناية عن كثرة اللبن، والضرع من الحيوان بمنزلة الثدي من المرأة، «وأمده خواصر»، أي: وكذلك تكون بطنها ممتلئة كأكثر ما يكون؛ لكثرة أكلها وخصب مرعاها، والمراد أن من آمن بالدجال، ينعم في أرض خصبة ووفرة من الطعام، فترجع ماشيته في المساء سمينة طويلة الأسنام.
ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي قوما آخرين غير الذين آمنوا به، فيدعوهم إلى الإيمان به، «فيردون عليه قوله» وينكرونه ولا يؤمنون به، فينصرف الدجال عنهم، فيأتي عليهم صباح اليوم التالي «ممحلين»، أي: مصابين بالقحط والجدب بسبب انقطاع المطر ويبس الأرض، «ليس بأيديهم شيء من أموالهم» وهو كناية عن موت مواشيهم، ويمر الدجال على الأرض «الخربة» وهي المهجورة، والتي ليس فيه بناء ولا زرع ولا أبنية وليس بها أنيس، فيقول لها: «أخرجي كنوزك» ومعادنك التي خلقها الله فيك، «فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» واليعاسيب: جمع يعسوب، وهو ذكر النحل وأميرها، والنحل تطير جنودا مجندة وراء أميرها وتذهب حيث ذهب، فكأنه قال: كما تتبع النحل يعاسيبها، والمعنى أن كنوز الأرض تتبع الدجال كما تتبع النحل أميرها، فشبه الدجال باليعسوب، والكنوز بالنحل، ثم يدعو الدجال رجلا «ممتلئا شبابا» أي: تاما كاملا قويا، فيضربه بالسيف، «فيقطعه جزلتين»، أي: قطعتين منفصلتين، مثل «رمية الغرض»، أي: يجعل بين القطعتين مقدار ما بين مكان رمية السهم وبين الهدف، أو يقطعه نصفين كرمية الهدف في السرعة والإصابة، ثم يدعوه الدجال ويناديه فيقبل ذلك المقتول ويأتي إلى الدجال «ويتهلل وجهه» أي: يقبل إليه وقد استنار وجهه وهو يضحك، والمعنى: يصير حيا بعدما كان ميتا، وهذا من الخوارق التي أمكن الله عز وجل الدجال منها فتنة واختبارا من الله، وليتميز الخبيث من الطيب، وقد ورد في الصحيحين: «فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا، ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه» وفي تمام الرواية: فلا يستطيع الدجال قتل هذا الرجل مرة أخرى.
فبينما الدجال على تلك الحال من القتل والإحياء للرجل؛ إذ بعث الله عز وجل وأرسل إليه المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، فينزل عند «المنارة البيضاء» وهي المئذنة البيضاء الكائنة «شرقي دمشق» وهي المدينة المشهورة بالشام، ولا ينافي نزوله هذا ما ورد عن ابن ماجه أنه عليه السلام ينزل ببيت المقدس عند ابن ماجه؛ لأن بيت المقدس موجود في شرقي دمشق، وهو معسكر المسلمين إذ ذاك.
وينزل عيسى عليه السلام لابسا «مهرودتين»، يعني: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه السلام، «واضعا كفيه على أجنحة ملكين» حيث تنزله الملائكة من السماء إلى الأرض، «إذا طأطأ رأسه قطر» أي: إذا خفض عيسى عليه السلام رأسه تنزل منه قطرات الماء سريعا «وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ»، أي: نزل قطرة بعد قطرة، والجمان: حبات مصنوعة من الفضة على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد: يتحدر منه الماء أو العرق على هيئة اللؤلؤ في الصفاء والحسن، وهذا كناية عن جمال ذات عيسى عليه السلام وحسن خلقته مع جمال ملبسه. قال صلى الله عليه وسلم: «فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» أي: إن الكفار لا يقربونه، وإنما يهلكون عند رؤيتهم لعيسى عليه السلام، ووصول نفسه إليهم حفظا من الله تعالى له وإظهارا لكرامته، «ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» والمعنى: أن نفسه عليه السلام يصل إلى مسافات بعيدة بمثل مستوى بصره، فيطلب عيسى ابن مريم الدجال ويتتبعه «حتى يدركه بباب لد» اسم قرية في فلسطين من قرى بيت المقدس، فيقتل عيسى عليه السلام الدجال.
ثم يأتي إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام قوم قد عصمهم الله وحفظهم من شر الدجال وفتنته، فيمسح عيسى عليه السلام عن وجوههم ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في إكرامهم واللطف بهم، وقيل: معناه يكشف ما نزل بهم من الخوف والمشقات والحزن والكآبة على وجوههم بما يسرهم من خبره بقتل الدجال، ويرحمهم ويواسيهم ويتلطف بهم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: «إني قد أخرجت عبادا لي» من مكان محبسهم «لا يدان» أي: لا قدرة ولا طاقة «لأحد بقتالهم» والمراد بمن أخرجهم الله يأجوج ومأجوج، وكان قد حبسهم الله عز وجل بسد قد أقامه عليهم ذو القرنين، «فحرز عبادي»، أي: ضمهم واجمعهم «إلى الطور» وهو جبل في سيناء بمصر، فأمره سبحانه أن يرتحل ويختبئ بهم إلى هذا الجبل.
«ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهما قبيلتان كبيرتان من جنس الناس مفسدون في الأرض، يخرجون بعد هلاك الدجال، لا طاقة لأحد بهم، مقبلين «وهم من كل حدب» من كل مرتفع «ينسلون» مسرعين للإفساد في الأرض بأعداد كثيرة، «فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» وهي بحيرة تقع في فلسطين بين منطقتي الجليل والجولان بالقرب من مسار نهر الأردن، «فيشربون ما فيها» يعني: أن المتقدمين منهم يشربون ماء البحيرة كله حتى لا يبقى من الماء فيها إلا آثار، فيمر عليها آخرهم، فيدركون بهذه الآثار أنه كان فيها ماء أولا، وفي رواية: أنهم يسيرون حتى ينتهوا إلى «جبل الخمر»، والخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وهو جبل بيت المقدس كما فسره الراوي، «فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض»، وهذا بزعمهم؛ لأن عيسى عليه السلام وأصحابه يكونون محصورين مستورين، ثم يقولون لبعضهم: «هلم» أي: تعالوا وأقبلوا إلى قتال من في السماء، «فيرمون بنشابهم» أي: سهامهم إلى جهة السماء، فيرد الله عليهم نشابهم «مخضوبة دما»، أي: مصبوغة دما، وهذا استدراج منه سبحانه، مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور.
«ويحصر» أي: يحبس «نبي الله عيسى وأصحابه» على جبل الطور بلا طعام ولا شراب، ويصل بهم حد نفاد أغذيتهم وطعامهم، وهم محاصرون بيأجوج ومأجوج حتى لا يوجد رأس الثور، وهو فحل البقر، مع أن رأس الثور لا يرغب فيه الناس مثل رغبتهم في لحم باقي أعضاء البقر، وإنما ذكر رأس الثور ليقاس البقية عليه في القيمة، وهذا كناية عن شدة حاجتهم وجوعهم، «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» إلى الله، فيتضرعون له ويدعونه أن يرفع عنهم هذا البلاء، ويدعونه بالفرج من هذه المحاصرة والمجاعة، «فيرسل الله» على يأجوج ومأجوج ويسلط عليهم «النغف» وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فيكون هذا الدود «في رقابهم» وهذا استجابة لدعاء عيسى عليه السلام وأصحابه، «فيصبحون فرسى» أي: قتلى «كموت نفس واحدة»، أي: أنهم يموتون كلهم كموت نفس واحدة.
ثم بعد هلاك يأجوج ومأجوج؛ يهبط نبي الله عيسى وأصحابه من جبل الطور إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا «ملأه زهمهم ونتنهم»، أي: دسمهم ورائحتهم الكريهة المنتنة، «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله»، أي: يتضرعون له ويدعونه أن يرفع عنهم هذا البلاء، «فيرسل الله» على موتى يأجوج ومأجوج «طيرا» طوال الأعناق وغلاظها «كأعناق البخت»، وهي الإبل التي تكون طوال الأعناق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم بعد نقل تلك الطيور موتى يأجوج ومأجوج؛ يرسل الله مطرا «لا يكن منه»، أي: لا يستر، ولا يمنع من نزول الماء، «بيت مدر» وهو الطين الصلب «ولا وبر» والوبر للإبل بمنزلة الشعر للمعز وبمنزلة الصوف للضأن، وهذا يدل على كثرة المطر وغزارته، فيغسل ماء المطر الأرض وينظفها من آثار جيف يأجوج ومأجوج «حتى يتركها كالزلفة» وهي المرآة، والمراد: أن الماء يعم جميع الأرض بحيث يرى الرائي وجهه فيه، وعند الترمذي: «ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين».
ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت أشجارها وثمارها، وأن ترد بركتها مما ينتفع به الإنسان والحيوان والطير، فيومئذ تأكل «العصابة»، والمراد بها: الجماعة من الناس، من ثمرة الرمانة الواحدة ويشبعون منها لكبرها، وذلك من بركة الأرض، «ويستظلون» من حر الشمس «بقحفها»، أي: بقشرها، والمراد أن الرمانة تكون كبيرة بحيث تستظل بقشرتها الجماعة من الناس، «ويبارك في الرسل»، وهو اللبن، فينزل الله فيه البركة «حتى أن اللقحة من الإبل»، وهي: الناقة ذات اللبن، ليكفي لبنها «الفئام من الناس»، أي: الجماعة الكبيرة، وهي أكثر من القبيلة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي «الفخذ من الناس» وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى جد قريب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة.
فبينما الناس كذلك يتمتعون بهذا النعيم وما يخرج لهم من بركات الأرض؛ إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تلك الريح بألم يظهر «تحت آباطهم» وهو ما تحت مجتمع الكتف والعضد، «فتقبض» أي: تكون تلك الريح سببا لقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ولا يبقى على الأرض إلا «شرار الناس» وهم الكفار وغير الموحدين «يتهارجون فيها تهارج الحمر»، أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير، لا يكترثون لذلك، فعلى هؤلاء تقوم القيامة وينفخ في الصور.
وفي الحديث: بيان فتنة الدجال.
وفيه: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات، وبعض من علامات الساعة.
وفيه: بيان شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال.
وفيه: بيان عناية الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله على هذه الأمة؛ حيث يستطيع كل مسلم أن يدفع عن نفسه فتنة الدجال.
وفيه: بيان بعض ما يظهر على يدي الدجال من الشبهات، كأمره السماء أن تمطر، والأرض أن تنبت في يوم واحد.
وفيه: التنويه بنزول عيسى عليه السلام رحمة من الله لهذه الأمة؛ حيث يقتل الدجال بباب لد، فيريح المؤمنين، ويقتل الكافرين.
وفيه: ذكر يأجوج ومأجوج وما يكون من شرهم ثم إهلاكهم.
وفيه: بيان لطف الله تعالى بالمؤمنين عند نزول يأجوج ومأجوج.

 غندر
غندر