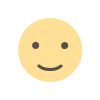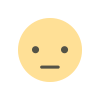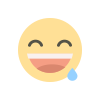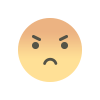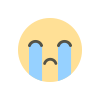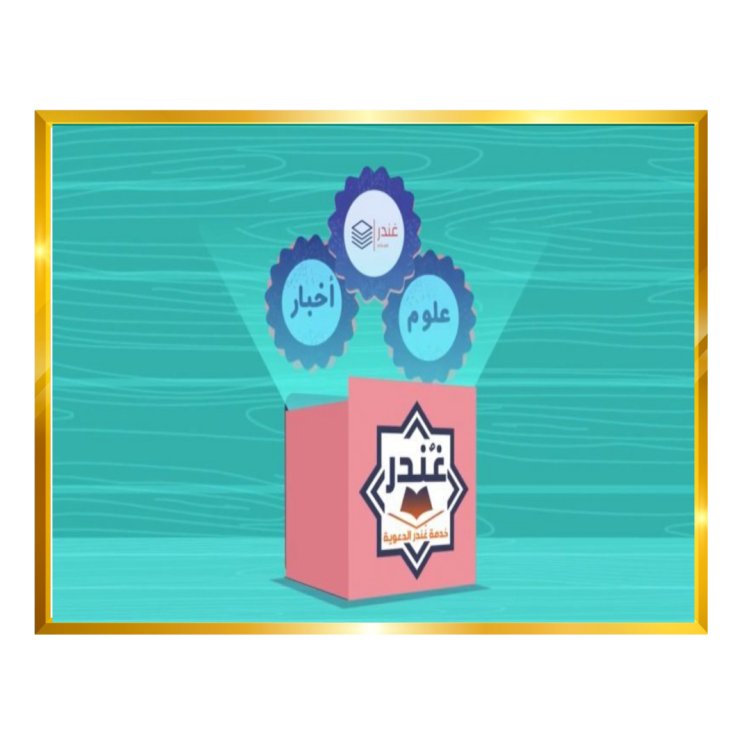باب استحباب الاجتماع على القراءة
بطاقات دعوية

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده». رواه مسلم. (1)

حث الشرع على التحلي بالفضائل ومحاسن الأخلاق، مثل قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم ونفعهم بما يتيسر من مال وعلم أو معاونة أو مشاورة
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة»، أي: رفع عن مؤمن حزنا وعناء وشدة، ولو كان يسيرا، فيكون الثواب والأجر أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وتنفيس الكرب إحسان، فجزاه الله جزاء وفاقا، «ومن يسر على معسر»، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، أي: عليه دين، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة مقابل تيسيره على عبده؛ مجازاة له بجنس عمله، «ومن ستر مسلما»، أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس، فيكون جزاؤه أن يستره الله في الدنيا، أي: يستر عورته أو عيوبه، ويستره في الآخرة عن أهل الموقف. وهذا فيمن كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة، فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه
وقوله: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، أي: من أعان أخاه أعانه الله، ومن كان ساعيا في قضاء حاجات أخيه، قضى الله حاجاته؛ فالجزاء من جنس العمل
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن «من سلك طريقا يلتمس فيه علما»، وهذا يشمل الطريق المعنوي والطريق الحسي؛ فأما المعنوي فهو الطريق الذي يتوصل به إلى العلم؛ كحفظ العلم، ومدارسته ومذاكرته، ومطالعته وكتابته، والتفهم له، بأن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب؛ فمن يستمع إلى العلماء، أو يراجع الكتب ويبحث فيها -وإن كان جالسا-؛ فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما، وأما الطريق الحسي فهو الذي يجتهد فيه المرء، ويسير فيه على الأقدام؛ مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجدا، أو مدرسة، أو جامعة، أو غير ذلك، نة«سهل الله له به طريقا إلى الج»، أي: يسر الله له عملا صالحا يوصله إلى الجنة بفضل الله ورضوانه عليه، فيوفقه للأعمال الصالحة، أو المراد: سهل عليه ما يزيد به علمه؛ لأنه أيضا من طرق الجنة، بل هو أقربها؛ لأن العلم الشرعي تعرف به أوامر الله ونواهيه، فيستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل، ويوصل إلى الجنة، ويكون طلب العلم وتحصيله باتخاذ كل الوسائل المستطاعة وإن لم يكن هناك سفر؛ كأن يلازم مجالس العلم، ويقتني الكتب النافعة المفيدة لأجل دراستها والمذاكرة فيها
وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» ويلحق بها دور العلم ونحوها، وبيوت الله في الأرض المساجد، وأضاف الله عز وجل هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما، ولأنها محل ذكره، وتلاوة كلامه، والتقرب إليه بالصلاة. «يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم»، بأن يقرأه بعضهم على بعض، ويتدبروا معانيه، ويتدارسوا أحكامه، ويتعهدوه خوف النسيان؛ إلا منحهم الله عز وجل الأجر الجزيل فضلا منه سبحانه وكرما، ثم يبين صلى الله عليه وسلم فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد ومدارسته، وأن الله يمنح لمن جلس هذه المجالس أربع منح، أولها: أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم، وهي ما يحصل به صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمته النفسانية، مع الطمأنينة والوقار، ومن ثم يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك، راضيا بقضاء الله وقدره. وهذه السكينة نعمة عظيمة من الله تعالى، قال عنها: {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم} [الفتح: 4]. والمنحة الثانية: «وغشيتهم»، أي: غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. والمنحة الثالثة: «وحفتهم الملائكة»، أي: التفوا حولهم؛ تعظيما لصنيعهم، واستماعا لذكرهم الله عز وجل، وليكونوا شهداء عليهم بين يدي الله عز وجل. والمنحة الرابعة: «وذكرهم الله فيمن عنده» من الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى مباهاة بهم.
ثم يختم صلى الله عليه وسلم الحديث بالحث على علو الهمة في العلم والعمل، وعدم التواكل على الحسب أو النسب، أو أي عرض من أعراض الدنيا، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم «أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»، من كان عمله ناقصا، لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال؛ فينبغي ألا يتكل على شرف النسب، وفضيلة الآباء، ويقصر في العمل.
وفي الحديث: أن الجزاء من جنس العمل.
وفيه: فضيلة إعانة الغير.
وفيه: الحث على طلب العلم وتلاوة القرآن وتدارسه.

 Khurshid
Khurshid