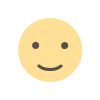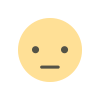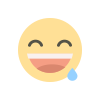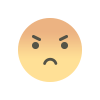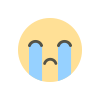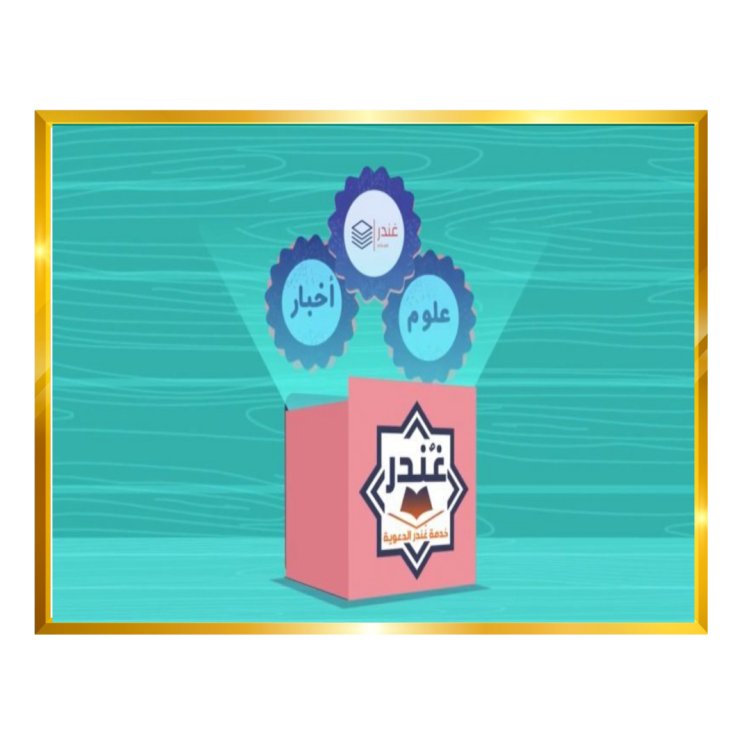لا أحب الآفلين
بطاقات دعوية

خلق الله الخلق لعبادته وبذكره تطمئن قلوبهم؛ وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم،
فلا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه؛ ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به.
وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم؛ وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح؛ ولا نعيم ولا لذة؛ بدون ذلك بحال.
بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن لا يعذبهم} .
فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به، ويتنعم بالتوجه إليه؛ إلا الله سبحانه؛
ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل طعام المسموم {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون}
فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها.
ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص،
ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده، ويضره ذلك.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه؛ ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم {لا أحب الآفلين} .وأعظم آية في القرآن الكريم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} . والقيوم هو الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم، ولا يفنى بوجه من الوجوه.

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصلين:
أحدهما: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، وكما دل عليه القرآن؛
لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: أن عبادته تكليف ومشقة، وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار؛ أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم؛
فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنًا، ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ كقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . {لا تكلف إلا نفسك} {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} أي وإن وقع في الأمر تكليف؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفًا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم،
وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه، وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا.
الأصل الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق: من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: {اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة} . رواه النسائي وغيره وفي صحيح " مسلم " وغيره عن " صهيب " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو ألم يبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه - سبحانه. فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة} . فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه؛ وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له، وتنعمه به أعظم.