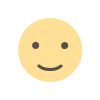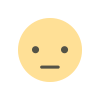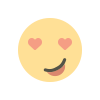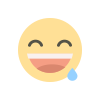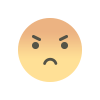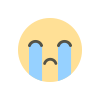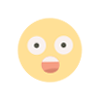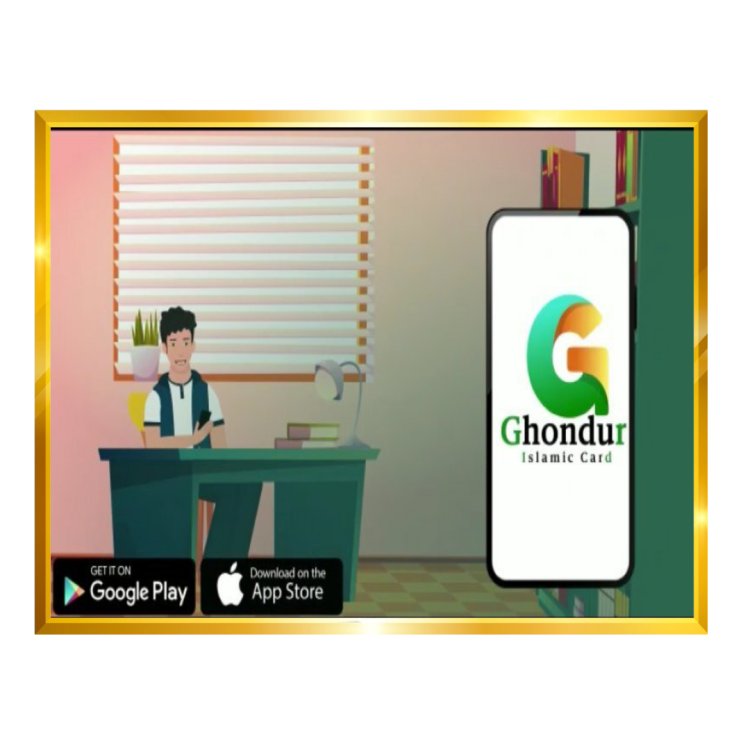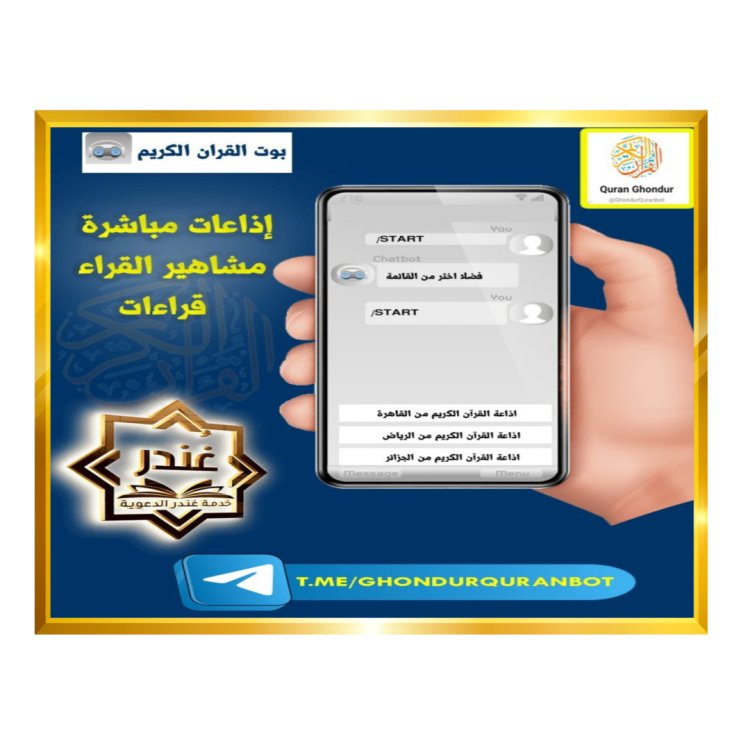مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 265
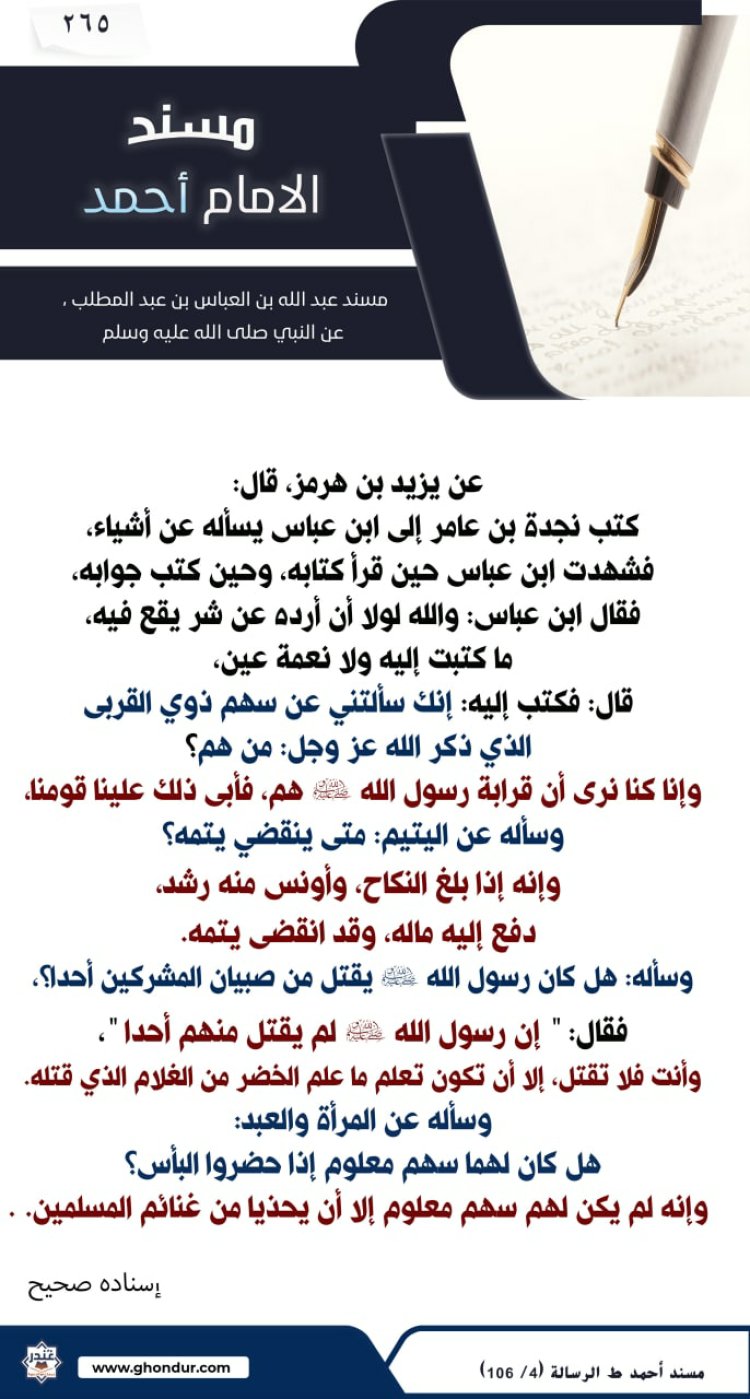
حدثنا عفان، أخبرنا جرير بن حازم، أخبرنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل: من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، دفع إليه ماله، وقد انقضى يتمه. وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا "، وأنت فلا تقتل، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله. وسأله عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين

ظلت الخوارج على عهد الصحابة رضي الله عنهم يجادلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونهم في دينهم؛ ظنا من الخوارج أنهم على حق
وفي هذا الحديث يروي التابعي يزيد بن هرمز أن نجدة بن عامر الحروري -وكان من الخوارج، ينسب إلى حروراء، موضع قريب من الكوفة، وهي البلد التي اجتمع فيها أول أمر الخوارج- كتب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال، أي: مسائل يستفتيه فيهن، وعند النسائي أن ذلك كان في الزمن الذي كانت فيه فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد بالخلافة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه»؛ وذلك لأن نجدة من الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك استثقل ابن عباس رضي الله عنهما مجاوبته وكرهها، لكن أجابه؛ مخافة كتم العلم ووعيد كاتمه، وكان نجدة كتب إليه: «أما بعد» وهي كلمة يفصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من كلام إلى غيره، «فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟» أي: يصحبهن في غزواته وجهاده ويخرج بهن؟ «وهل كان يضرب لهن بسهم؟» فيجعل لهن حظا ونصيبا من الغنيمة كما يجعل للرجال المحاربين؟ «وهل كان يقتل الصبيان؟» وهم الأطفال الصغار من أولاد أهل الحرب المشركين «ومتى ينقضي يتم اليتيم؟» وهو الذي مات أبوه قبل البلوغ، والمراد: متى ينتهي حكم يتمه بحيث يجب على وليه دفع ماله إليه، ويستقل هو بالتصرف فيه، «وعن الخمس» من الغنيمة «لمن هو؟» من يأخذه ويتصرف فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا له عن أسئلته؛ فأما عن غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «قد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى» لا أنهن يقاتلن العدو، ففي صحيح مسلم، عن أم عطية الأنصارية، قالت: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ويحذين من الغنيمة» أي: يعطين الحذوة وهي العطية، وتسمى الرضخ، والرضخ العطية القليلة، ولا يسهم لهن منها، أي: لا يضرب لهن بسهم مقدر كسهم الرجال
ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان» بل كان ينهى عن ذلك، والحكم يشمل النساء أيضا، فنهى ابن عباس رضي الله عنهما نجدة عن قتل الصغار في الحرب؛ «لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فأما إذا قاتلوا فيجوز قتلهم، وفي رواية: «إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل» يعني: أن قتل الخضر لذلك الصبي كان بأمر الله تعالى له بذلك، وبعد أن أعلمه الله تعالى أن قتل ذلك الغلام مصلحة لأبويه، وهذا النوع من العلم يتعذر على السائل وغيره ممن لا يعلمه الله بذلك، فلا يحل قتل صبي، وفي رواية: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن؛ معناه من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنا ومن يكون إذا عاش كافرا؛ فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله، ولا سبيل إلى هذا التمييز فلا يحل قتلهم
ثم أجابه ابن عباس رضي الله عنهما عن حكم اليتيم، ومتى ينتهي حكم يتمه ويستقل بالتصرف في ماله؟ ولا يكون هذا إلا إذا كان عارفا بوجوه أخذه وإنفاقه، أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. فأقسم ابن عباس رضي الله عنهما: «لعمري» أي: بالذي يحييني، «إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» يعني أنه ضعيف في المطالبة بحقوقه من الناس، ويكون أيضا ضعيف الإعطاء والأداء لحقوق الناس، «فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» أي: فإذا صار حافظا لماله عارفا بوجوه أخذه وإعطائه، وظهر منه الرشد في معاملته مع الناس؛ فقد رفع عنه حكم اليتم ويعطى ماله
ثم جاوبه رضي الله عنهما عن الخمس لمن هو؟ أراد به خمس الخمس الذي جعله الله لذوي القربى، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لبني هاشم وبني عبد المطلب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، «فأبى علينا قومنا ذاك» أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وهذا اجتهاد اختلف فيه ابن عباس رضي الله عنهما مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأى أنهم يستحقونه بالحاجة فقط، وهم يقولون: هو حقنا، ولو كنا غير محتاجين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قسمه بيننا، على ظاهر الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } [الأنفال: 41]الآية
وفي الحديث: النهي عن كتمان العلم.
وفيه: أن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الإسهام للنساء في الحرب.
وفيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب.
وفيه: إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة لو لم يفتهم.
وفيه: أخذ العلم بالمكاتبة والمراسلة.
وفيه: بيان قسم الفيء، وحل الغنائم.