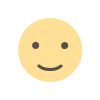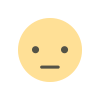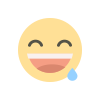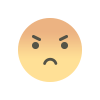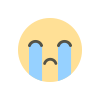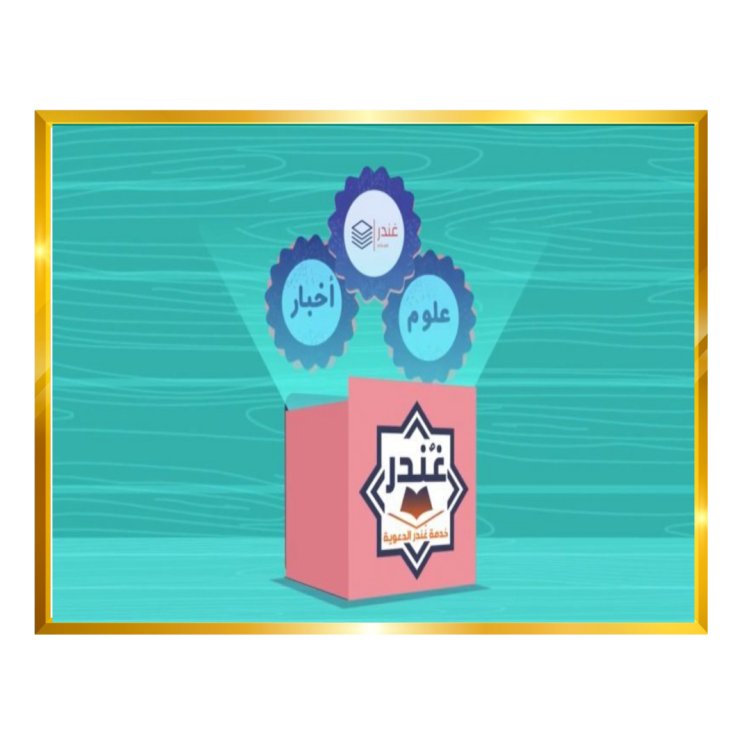مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 928

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، - يزيد أحدهما على الآخر - عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس: " أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة فذكر الحديث "
قال ابن عباس: " رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا "
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فألفى ذلك أم إسماعيل، وهي تحب الأنس، فنزلوا، وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم " - وقال في حديثه -: " فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت: هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات " قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فلذلك سعي الناس بينهما " (2)

كانت سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام مليئة بالحكم والمواعظ والأحكام والمواقف التي يتعلم منها كل مؤمن وكل إنسان حكيم
وفي هذا الحديث يحكي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أول من اتخذ من النساء «المنطق» -وهو قطعة من قماش تشد بها المرأة وسطها، وتجر أسفله على الأرض- كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وسببه أن سارة كانت قد وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام، فلما ولدت إسماعيل غارت منها، فشدت هاجر المنطق على وسطها، وصارت تجر أسفله على الأرض؛ لتخفي آثار أقدامها على سارة، ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذهب بهاجر وإسماعيل إلى مكة، ففعل، ولم يكن هناك بيت ولا بناء ولا زرع ولا ماء، فوضعها تحت شجرة هناك فوق مكان زمزم، وكان إسماعيل رضيعا، ومكة صحراء قاحلة، وترك لها جرابا -وهو وعاء مصنوع من جلد- فيه بعض التمر وسقاء ماء، «ثم قفى إبراهيم منطلقا»، أي: عاد راجعا إلى الشام، فسألته هاجر: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وأعادت السؤال مرارا، فلما لم يجبها، سألته: هل أمرك الله بذلك؟ فأجابها: نعم، فذكرت أنه ما دام الله سبحانه قد أمرك بذلك، فلن يضيعنا
فمشى إبراهيم عليه السلام، فلما وصل إلى الثنية -وهي الطريق العالي في الجبل، ومكانها أعلى مكة المكرمة- تضرع إلى الله تعالى متوجها إلى بيته الحرام، داعيا: {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع}، لا نبات فيه {عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة}، أي: إنما جعلته محرما؛ ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}، فاجعل جماعات من الناس تأتيهم وتأنس بهم وتقيم معهم، {وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون}، أي: ليشكروك على ما رزقتهم ويكون عونا لهم على طاعتك
وجعلت هاجر ترضع إسماعيل عليه السلام، وتشرب من ذلك الماء الذي في الوعاء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه «يتلوى»، أي: يتلفت ويتألم ويحرك جسده، أو «يتلبط»، أي: يحرك لسانه، ويكاد يموت من شدة العطش، فلم تطاوعها نفسها أن تراه على تلك الحالة، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على وشك أن يموت من العطش، ثم سعت سعي الإنسان المتعب تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات، فشرع الله للناس السعي في الحج من أجل ذلك. فلما أشرفت وقاربت على جبل المروة سمعت صوتا، فقالت: «صه» تريد نفسها، كأنها طلبت من نفسها السكوت؛ لكي تتعرف عن مصدر الصوت، ومن أين أتى؟ ثم أنصتت وتسمعت، فسمعت أيضا الصوت مرة أخرى، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك «غواث»، يعني: قد سمعت صوتك، فإن كان عندك ما يغيثني فأغثني. فإذا هي بالملك -وهو جبريل عليه السلام- عند مكان زمزم، فبحث بعقبه، أي: حفر أو ضرب في الأرض بطرف رجله أو جناحه، وهو كناية عن سهولة إخراج الماء، فجعلت تحوضه، وتقول بيدها هكذا، أي: فصارت تحيطه بالتراب وتجعله حوضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزم عينا معينا»، أي: عينا جارية على وجه الأرض. فقال لها الملك: لا تخافوا الضياع والهلاك؛ لأنكم تحت رعاية الله تعالى، وإن هذا المكان هو مكان بيت الله، وسيبنيه هذا الغلام وأبوه إبراهيم عليهما السلام
وكان البيت الحرام مرتفعا من الأرض كالرابية -وهي ما ارتفع من الأرض-؛ وذلك بسبب أن السيول كانت تتوالى عليه، فتأخذ من جوانبه حتى قل بناؤه، ثم مر بذلك المكان، أو بالقرب منه جماعة مسافرون من قبيلة جرهم مروا من طريق كداء، وهي بأعلى مكة، فرأوا طيرا «عائفا»، أي: يتردد على الماء ويحوم، فعرفوا أن بهذا الوادي ماء، وكان عهدهم به أنه واد لم يكن به ماء ولا زرع، فأرسلوا رجلا أو رجلين؛ ليكشفا لهم عن الحقيقة، فرجع إليهم رسلهم يخبرونهم عن وجود ماء في تلك البقعة، فأقبلوا على أم إسماعيل، واستأذنوا منها بالنزول في جوارها، فأذنت لهم، على ألا يكون لهم حق التملك في ذلك الماء، وإنما لهم أن يشربوا منه فقط، وسكنت جرهم مكة منذ ذلك العهد، واستأنست هاجر بسكناهم معها، وكبر إسماعيل عليه السلام في هذه القبيلة، وتعلم منهم اللغة العربية، ثم لما بلغ الرشد زوجوه امرأة منهم اسمها عمارة بنت سعد، ثم ماتت هاجر أم إسماعيل عليه السلام
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل عليهما السلام، يطالع تركته، أي: يتفقد حال أهله وولده، فلم يجد إسماعيل عليه السلام في بيته، فسأل امرأته عنه، ولم تعرف أنه إبراهيم أبو إسماعيل عليهما السلام، فقالت: خرج يبتغي لنا، أي: يطلب لنا الرزق، ثم سألها عن عيشهم وحالتهم، فقالت: نحن بشر -ضد الخير-، نحن في ضيق وشدة، وجعلت تشكو إليه معيشتهم، فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له: يغير عتبة بابه، فالعتبة كناية عن المرأة، والباب كناية عن البيت، فلما جاء إسماعيل عليه السلام -وكان قد أحس في نفسه أنه جاءها أحد- سألها قائلا: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم؛ جاءنا شيخ كذا وكذا، تصفه له، وأخبرته بما حدث بينهما. فقال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، أي: أطلقك، فالحقي بأهلك، أي: أنت طالق، فاذهبي إلى أهلك، ثم تزوج إسماعيل عليه السلام منهم امرأة أخرى، ثم أتى إبراهيم عليه السلام بعد مدة من الزمن، فلم يجد ابنه إسماعيل في بيته، فدخل على امرأته، فسألها عنه، فقالت: خرج يسعى في طلب الرزق. قال: كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وحالهم، فقالت: نحن بخير وفي نعمة من الله وسعة في الرزق، وأثنت على الله سبحانه، فحمدت ربها وشكرته؛ لأنها كانت راضية بما قسم لها، وذلك شأن المرأة الصالحة، فسألها عن طعامهم وشرابهم الذي يعيشون عليه، فذكرت أن طعامهم اللحم، وشرابهم الماء. فدعا لهم بالبركة في اللحم والماء، فكانوا يقتصرون عليهما دون أن يتضرروا منهما، وأصبح ذلك خاصا بمكة دون غيرها من البلاد؛ فإنه لا يقتصر أهل بلد عليهما إلا تضرروا منهما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه»، أي: ليس أحد يعيش على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولم يكن لهم يومئذ حب»، يقصد القمح ونحوه، ولو كان عندهم حب ومنه طعامهم، لدعا لهم فيه بمثل ما دعا في اللحم والماء.
ثم قال إبراهيم عليه السلام لامرأة إسماعيل: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل عليه السلام، قال: هل أتاكم أحد؟ فأخبرته عن الشيخ الذي جاءها في غيابه، وبأوصافه وما دار بينه وبينها. فقال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، فأبقيك ولا أطلقك
ثم جاء إبراهيم عليه السلام زائرا لابنه مرة ثالثة، وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا -أي: سهما- ويصلحه تحت شجرة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد؛ من المعانقة والتقبيل ونحوهما، ثم أخبر إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام أن الله سبحانه أمره أن يقوم بعمل في هذا المكان، وطلب من ولده إسماعيل عليه السلام أن يعينه عليه، فوافق إسماعيل عليه السلام، فقال إبراهيم عليه السلام: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى «أكمة مرتفعة»، وهي مكان مرتفع قليلا عن سطح الأرض؛ ليبين له المكان الذي أمر ببناء الكعبة فيه، قال: فعند ذلك رفعا القواعد، أي: شرعا في البناء حتى رفعا الأسس التي يقوم عليها البيت. فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ارتفع البناء وعلا وأصبح لا تطوله يده، جاء بهذا الحجر، فقام ووقف عليه إبراهيم عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وهما يقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم}، فيدعوان الله بقبول بنائهما هذا، والرضا عنهما فيه؛ لأنه السميع لدعائهما، العليم ببنائهما. فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [البقرة: 127]
وفي الحديث: بيان تحمل إبراهيم عليه السلام وزوجته وولده وصبرهم في ذات الله سبحانه
وفيه: أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه
وفيه: ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام خليل الله حقا، وأن محبته لله قد تغلبت على كل مشاعره، فأطاعه في كل شيء حتى في مفارقة ولده
وفيه: أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وأن هاجر كانت أول من سعى بينهما
وفيه: أن العرب ليسوا جميعا من نسل إسماعيل عليه السلام؛ لأن قبيلة جرهم العربية كانت قبل إسماعيل عليه السلام
وفيه: أن المرأة الكثيرة الشكوى والتبرم من عيشها، والجاحدة لنعمة الله عليها؛ هي في الحقيقة امرأة سوء
وفيه: خصوصية مكة المكرمة في الجمع بين اللحم والماء وحدهما دون أن يمرض الإنسان منهما