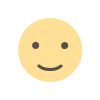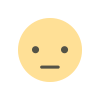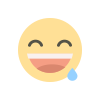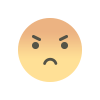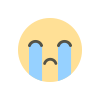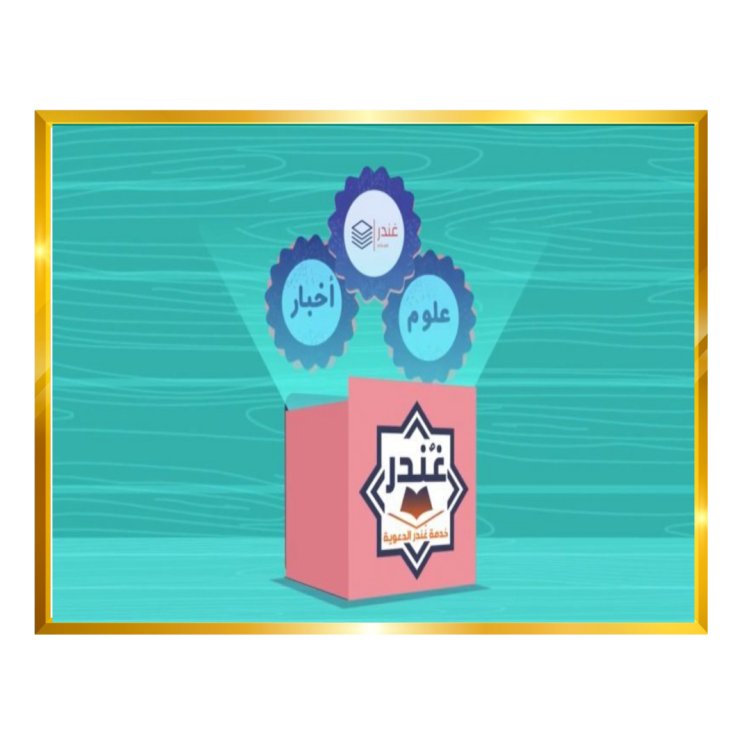باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف
بطاقات دعوية
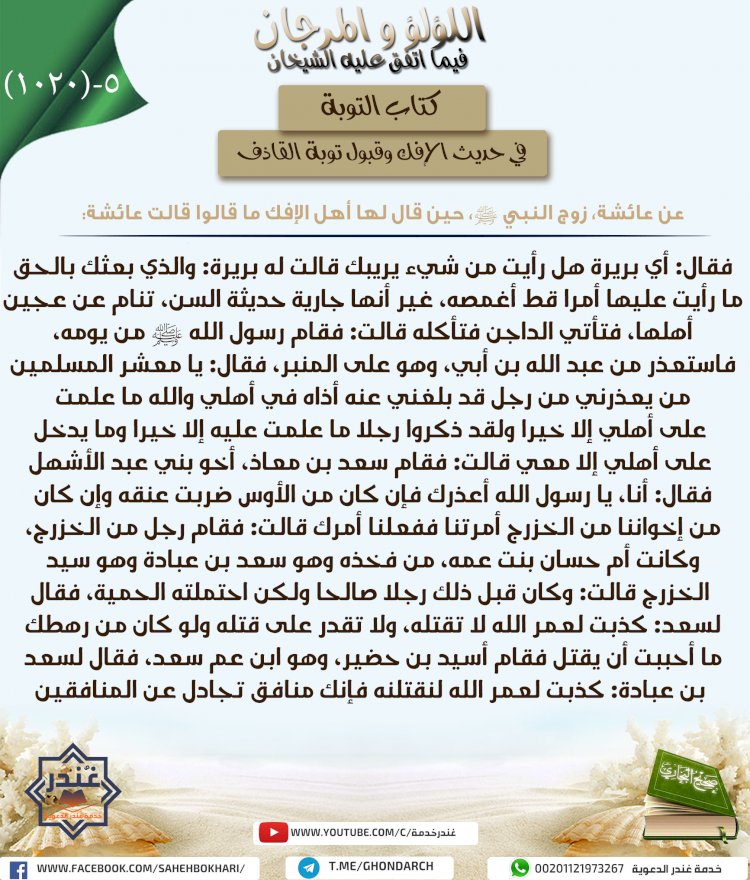
فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، غير أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله
قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي، وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي قالت: فقام سعد بن معاذ، أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا، يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه، من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين

قصة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها بهتانا وكذبا؛ كانت من أعظم الحوادث، وكانت اختبارا حقيقيا لصدق الإيمان لدى كثير من المسلمين، وقد أنزل الله بيانا واضحا لبراءتها، وهذا من فضل الله عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها
وفي هذا الحديث تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج إلى السفر يجري قرعة بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها صحبها معه، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق، وتسمى المريسيع، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة، وكان ذلك بعد أن أنزل الله آية الحجاب، فخرجت معه إليها، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وعاد، واقتربوا من المدينة؛ أعلن عن رحيله، وأعلم الناس بذلك، فقامت عائشة لقضاء حاجتها قبل الرحيل، ولما انتهت من قضاء حاجتها، أقبلت إلى مكان جملها ورحلها، فلمست صدرها، فإذا عقدها الذي من جزع أظفار -وهو الخرز اليماني- قد انقطع، فرجعت إلى المكان الذي قضت فيها حاجتها لتبحث عنه، فتأخرت عن العودة، فرحل القوم وذهبوا من المكان دون عائشة رضي الله عنها، ظنا منهم أنها معهم، ولم يلاحظوا خفة هودجها لخفة أجسام النساء في ذلك الوقت؛ فلم يكن ممتلئات كثيرات الشحوم؛ لأنهن إنما كن يأكلن «العلقة»، وهو القليل من الطعام الذي يسد الجوع.
فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أنها انتظرت القوم يرجعون إليها عندما يشعرون بفقدانها، فغلبها النعاس فنامت مكانها، وقد كان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتفقد مخلفات الجيش بعد رحيله حتى يوصلها إلى أصحابها، فوجد عائشة رضي الله عنها نائمة، وكان يعرفها قبل فرض الحجاب، فاسترجع قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت عائشة رضي الله عنها على صوته، فغطت وجهها، ولم يتكلما بكلمة واحدة حتى ركبت الراحلة إلى أن وصلت إلى الجيش الذي كان قد سبقهما.
وقولها: «فهلك من هلك»، أي: هلك الذين اشتغلوا بالإفك عليها، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس المنافقين، وممن خاضوا فيه أيضا حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش.
وتحكي عائشة رضي الله عنها أنها مرضت حين قدمت المدينة شهرا، والناس يتناقلون ويخوضون في قول أصحاب الإفك، وهي لا تشعر بشيء بما يقال عنها وبما يتناولها به الناس، وكان يشككها ويوهمها حصول شيء أنها في هذه المرة من مرضها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليها كما كانت عادته معها من الشفقة واللطف والرفق بها حين تشتكي وتمرض، وإنما كان إذا دخل حجرتها اكتفى بالسلام، ثم يقول: «كيف تيكم؟» أي: كيف حالك؟ يشير إلى عائشة رضي الله عنها، فسأل عنها بلهجة فاترة، ودون أن يشعرها بشيء مما يقال، حتى «نقهت»، أي: شفيت وفاقت من مرضها، خرجت مع أم مسطح بنت أبي رهم رضي الله عنها ناحية المناصع، وهو المكان الذي يقضون فيه حاجتهم، وهو في آخر المدينة من جهة البقيع، وكان من عادة النساء ألا يخرجن إليه إلا ليلا، ومنه إلى الليل الآخر، وهذا تأكيد على أنهن كن لا يخرجن نهارا، وذلك أستر لهن، وكان ذلك قبل أن يتخذ الناس الكنف والحمامات قريبا من بيوتهم، وكانوا في ذلك مثل بقية العرب الأول يقضون حاجات الإنسان من التبول والتبرز في الصحراء في أماكن معروفة، وبينما هما تمشيان، تعثرت أم مسطح في مرطها، وهو الثوب الذي تلبسه، فقالت: تعس مسطح، تدعو على ابنها مسطح الذي قد خاض مع الناس بالكذب في أمر عائشة، فقالت لها عائشة: بئس ما قلت! أتسبين رجلا شهد بدرا؟! فأخبرتها بقول أهل الإفك وما يخوضون به في عرضها، فكان ذلك سببا في مضاعفة وجعها ومرضها.
فلما رجعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها بقوله: «كيف تيكم؟»، بادرته عائشة رضي الله عنها واستأذنته صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، فأذن لها، تريد بذلك أن تتأكد من أبويها عما يتحدث به الناس، فقالت لها أمها: «يا بنية، هوني» على نفسك الشأن وما يقال، «فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة»، أي: جميلة وحسناء، «عند رجل يحبها» تريد زوجها، «ولها ضرائر» جمع ضرة، وهي الزوجة الأخرى لذات الرجل، سميت بذلك؛ لأنها تتضرر بغيرها بالغيرة والقسم ونحو ذلك؛ «إلا أكثرن عليها»، أي: كان ذلك سببا في تناولها والكلام عليها، والمعنى: أن الناس والضرائر لا يتركون زوجة محبوبة إلى زوجها إلا وتكلموا في شأنها بما لا يليق، تريد أمها بذلك التهوين عليها. فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت: «سبحان الله! ولقد يتحدث الناس بهذا؟!» والمعنى: أن تلك الأكاذيب والنيل من الأعراض لا ينشأ من الغيرة التي بين الضرائر ونحوها؛ فهو أكبر من ذلك، فباتت عائشة رضي الله عنها ليلتها تلك حتى أصبحت وهي لا يرقأ لها دمع، أي: لا ينقطع عنها، ولا تكتحل بنوم، وهو تعبير عن عدم النوم من كثرة الهم والحزن.
وتحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم في فراق عائشة رضي الله عنها «حين استلبث الوحي»، أي: أبطأ نزوله وتأخر، فأما أسامة رضي الله عنه فقال: «أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا» فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأنه لا يعلم عن سيرتها وسلوكها إلا الخير والصلاح، وأما علي رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مسليا له: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، إشارة إلى طلاقها والزواج بغيرها، وإنما قال له علي رضي الله عنه ذلك؛ لما رأى ما عنده صلى الله عليه وسلم من الغم والقلق، ثم أشار علي رضي الله عنه أن يسأل جاريتها بريرة عنها، وذلك أن الجواري عادة ما تكون أقرب وأخبر بأمور سيدتها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، وسألها عما إذا رأت من عائشة رضي الله عنها ما يدعو للريبة والشك، فأقسمت وقالت: «إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط»، فنفت أنها رأت منها شيئا قد يعيبها، ثم أخبرت أنها فتاة صغيرة السن تغفل عن بعض الأمور، فتنام عن عجين أهلها -لبراءتها وطيب نفسها- فتأتي «الداجن» -وهو كل ما يألف البيوت شاة أو غيرها- فتأكله، وفي الصحيحين أنها قالت: «سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر»، فبرأتها من الفرية التي افتراها عليها المنافقون.
وقد تنازع أهل العلم في: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة؟
فمنهم من قال: يعلم براءتها، وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك؛ توقف، وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، فما بغت امرأة نبي قط؛ لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه .
وقال آخرون: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك، وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. والدليل على ذلك: أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة؛ فسؤاله لبريرة واستشارته لعلي وأسامة: دليل على حصول الشك فيها. وقالوا: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء؛ ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف، وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل.
وقال آخرون: إن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، والرد على أعدائه، وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها، ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي»، فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه، وحسن ظنه بربه وثقته به؛ وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه، وسر قلبه، وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر «فاستعذر»، أي: استنصر ممن آذاه في أهله، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول الذي كان كبير المرجفين بهذه الفرية -وكان ابن سلول أحد قادة ورؤساء الخزرج-، وأقسم أنه لا يعلم عن أهله إلا خيرا، يريد عائشة أو جميع زوجاته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفوان رضي الله عنه بقوله: «وقد ذكروا رجلا»، أي: اتهموه بالفاحشة، «ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي»، وهذا كناية عن حسن خلق صفوان رضي الله عنه، وأنه ممن يؤتمن ويوثق به، وحسن السيرة والسمعة عنده وعند الناس.
وكانت الأنصار تتكون من قبيلتي الأوس والخزرج، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وسعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، فلما سمع سعد بن معاذ رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قام وأقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينتقم له ممن آذاه؛ إن كان من الأوس قتلوه، ثم قال: «وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ففعلنا فيه أمرك»، وهذا من أدب سعد بن معاذ رضي الله عنه ومعرفته لحدود سيادته؛ أن توقف عن التصريح بالقتل فيهم كما فعل في حق من يسودهم، وترك الحكم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع التعهد أن يقيم فيه ما يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سعد بن عبادة رضي الله عنه -وكان من كبار الصحابة وفضلائهم- الحمية -وهي التعصب لغير الحق- ورد على سعد بن معاذ كلمته، وقال: «كذبت» أي: أخطأت، والعرب تقول لمن أخطأ: كذبت، وأقسم «لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على ذلك»؛ لأنه رأى أنه ليس من حق سعد بن معاذ أن يتدخل في أمر يتعلق بالخزرج، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه -وكان زعيما من زعماء الأوس- فقال لسعد بن عبادة: «كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه» نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «فإنك منافق تجادل عن المنافقين»، وهذا من التلاسن بينهم، ولم يقصد بذلك وصفه بالنفاق حقيقة، وإنما قال ذلك للمبالغة في زجره، ثم إن هذا السباب لا يقام له وزن؛ لأنه صدر في حالة غضب.
قالت عائشة رضي الله عنها: «فثار الحيان الأوس والخزرج»، أي: علت أصواتهم ومجادلاتهم، «حتى هموا» بقتال بعضهم بعضا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بهم ليسكتوا، حتى سكتوا، وسكت صلى الله عليه وسلم.
وظلت عائشة تبكي ولا يجف لها دمع، ولا تنام، وجاء أبواها إلى المكان الذي هي فيه من بيتهما، وظلت تبكي ليلتين ويوما حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، أي: يشقه؛ وذلك لأن الحزن وشدته أكثر ما يضر في الإنسان كبده، مؤثرا على باقي أعضاء الجسد، فزارتها امرأة من الأنصار، فجعلت تبكي معها من باب المواساة، وبينما هم على تلك الحال، إذ دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالسهم، ولم يكن جالسها من وقت أن اتهمت وقذفت، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في شأن عائشة رضي الله عنها شيء، أي: ليبت في الأمر ويقطعه، ويخبره بحقيقة الأمر، وإن كان يوحى إليه في أمور أخرى.
ثم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم سأل عائشة رضي الله عنها عما بلغه وأشيع عنها، وقال: «فإن كنت بريئة» غير متهمة، فإن الله عز وجل سيكفل تبرئتك ويظهرها، «وإن كنت ألممت بذنب» من الإلمام، وهو النزول النادر غير المتكرر، والمعنى: فعلت ذنبا ليس من عادتك، «فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه»، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، جف دمعها وتوقف؛ لهول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبت من أبيها وأمها أن يجيبا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافعا عنها، فقالا لها: والله ما ندري ما نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنهما في موقف يحتار له أعظم الرجال؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب، ومقامه فوق كل المقامات، وفي الجانب الآخر ابنتهما التي اتهمت بفاحشة شنيعة.
وهنا ردت عائشة رضي الله عنها عن نفسها مع صغر سنها آنذاك، وقولها: «لا أقرأ كثيرا من القرآن» قالت هذا توطئة لعذرها؛ لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام، فقارنت حالها بحال نبي الله يعقوب وأذى أبنائه له ولابنه يوسف عليهما السلام، ثم استرسلت وذكرت أن ما قيل عنها وما قذفت به مع صفوان رضي الله عنهما قد استقر في نفوس كل من سمعه حتى إن بعضهم صدقه دون بينة، فإن تبرئت منه -والله يعلم ذلك- لم يصدقوها، وإن اعترفت به صدقوها، ولا يسعها في هذا الموقف إلا الصبر والتسليم لأمر الله وانتظار الفرج والبراءة منه عز وجل، كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون} [يوسف: 18]، فهو وحده الذي يبرئها دون غيره، وهو سبحانه الذي يدافع عنها دون سواه، ثم رجعت إلى فراشها متحولة عنهم، وما كانت تظن أن الله سينزل براءتها من فوق سبع سموات، وقولها: «ولأنا أحقر في نفسي» ، أي: ترى في نفسها أنها أقل من أن ينزل القرآن بأمرها، وأكثر ما كانت ترجوه وتأمله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه يبرئها الله عز وجل فيها، ثم قالت: «فوالله ما رام مجلسه»، أي: لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا، ولم يخرج أحد من أهل البيت، حتى أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه ما كان يصيبه أثناء نزول الوحي حتى إن العرق «ليتحدر منه مثل الجمان»، أي: يسيل من وجهه الشريف مثل حبات اللؤلؤ، وذلك في اليوم شديد البرودة، «فلما سري»، أي: انكشف وارتفع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حال من السرور والضحك، وكان أول ما تكلم به أن ذكر لعائشة براءتها وأن تحمد الله على ذلك، وأمرتها أمها أن تقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكره على بشراه لها، فقالت عائشة رضي الله عنه: «لا والله، لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله»؛ وذلك لأن الله عز وجل هو الذي برأها، وأنزل الله تعالى: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم * لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين * لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون * ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم * ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين} [النور: 11 - 17]. فسمى الله عز وجل هذا القذف «إفكا» إعلانا عن كذبهم وافترائهم فيه، ثم هددهم بالعقوبة عليه في الدنيا والآخرة.
وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مسطح بن أثاثة رضي الله عنه؛ لقرابته منه، فأم مسطح سلمى كانت بنت خالة أبي بكر الصديق، وكان مسطح من الذين خاضوا في القول بالإفك، فغضب وقال: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله}، أي: لا يحلفوا على ألا يعطوا أقاربهم من أموالهم؛ لأنهم أساؤوا إليهم، {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} [النور: 22]، فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فأعاد إلى مسطح ما كان يعطيه، وكفر عن يمينه.
وتكمل عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سأل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها عن أمر عائشة، فقالت زينب: يا رسول الله، أحمي سمعي عن أن أقول: «سمعت» ولم أسمع، وبصري من أن أقول: «نظرت» ولم أنظر، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي -أي: زينب رضي الله عنها- التي كانت «تساميني»، أي: تضاهيني وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله وحفظها بالورع من أن تخوض في الباطل مع من خاضوا.
وفي الحديث: مشروعية القرعة بين النساء في السفر.
وفيه: بيان فضل عائشة رضي الله عنها، وتبرئتها القاطعة من التهمة الباطلة التي نسبت إليها بوحي صريح وقرآن يتلى.
وفيه: الاسترجاع عند المصائب، سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه.
وفيه: ملاطفة الرجل زوجته، وأن يحسن معاشرتها.
وفيه: السؤال عن المريض.
وفيه: فضيلة أهل بدر، والذب عنهم.
وفيه: مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور.
وفيه: خطبة الإمام الناس عند نزول أمر بهم.
وفيه: فضل ومنقبة لصفوان بن المعطل رضي الله عنه.
وفيه: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات.
وفيه: قبول التوبة، والحث عليها، وأن التوبة الصادقة لله عز وجل سبب لمغفرة الذنب.
وفيه: المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة.
وفيه: العفو والصفح عن المسيء.
وفيه: الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات.
وفيه: بيان فضيلة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها.

 Khurshid
Khurshid