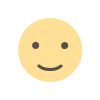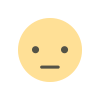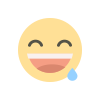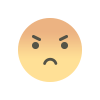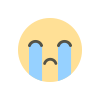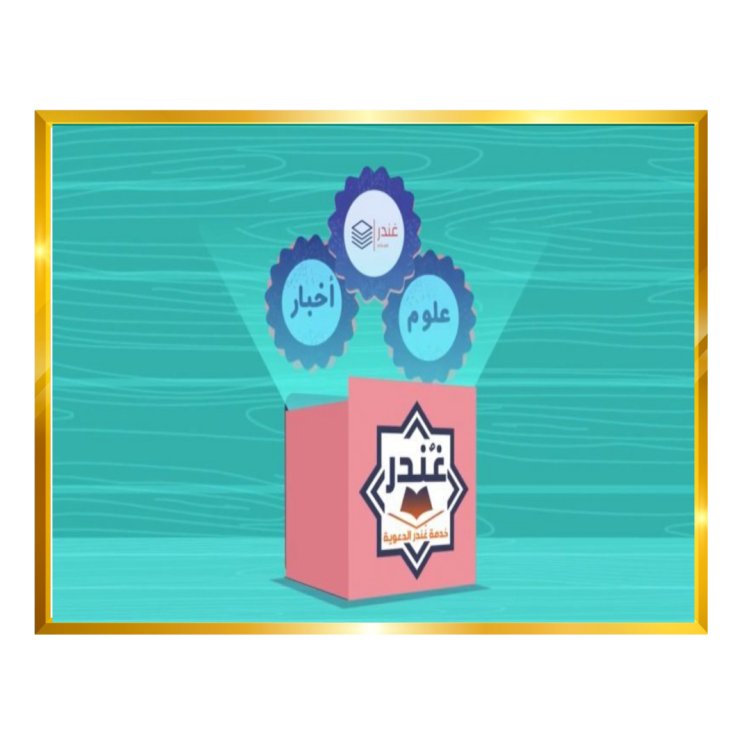مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 521

حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن رجلا، قال لعبد الله بن عباس: إن هذا الذي تقول، قد تفشغ في الناس - قال همام: يعني - " كل من طاف بالبيت فقد حل " فقال: " سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم " قال همام: " يعني من لم يكن معه هدي " (3)

الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو عبادة لمن استطاع إليها سبيلا، وتؤخذ جميع أعماله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون يذهبون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوهم ويتعلموا منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وأقواله في العبادات
وفي هذا الحديث يروي التابعي محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر -وهو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه دخل هو وآخرون على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فسأل عن الداخلين عليه واحدا واحدا، وكان جابر رضي الله عنه حينئذ أعمى؛ حيث عمي في آخر عمره، فلما وصل بالسؤال إلى محمد بن علي بن حسين، وقد أعلمه باسمه، مد يده إلى رأس محمد، فنزع زره الأعلى الذي يوضع في القميص، ثم نزع زره الأسفل، أي: أخرجه من عروته ليكشف صدره عن القميص ويضع يده عليه؛ لكمال الشفقة عليه؛ لكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحب به، وفعل جابر معه ذلك تأنيسا له لصغره، حيث كان محمد يومئذ غلاما شابا، وقال له: «مرحبا بك يا ابن أخي» أراد به أخوة الدين لا النسب، وكل فعل جابر هذا هو من باب تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم، وتمييزهم على غيرهم وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم
وطلب منه جابر رضي الله عنه أن يسأله عما يشاء، فسأله، وجاء وقت الصلاة، فقام جابر رضي الله عنه في ملحفة أو بردة منسوجة، ملتفا بها، كلما وضعها على منكبه -وهو مجتمع أول الذراع مع الكتف- سقط عن كتفه طرفاها من صغرها، ورداؤه -وهو الثوب الذي يستر النصف الأعلى من الجسد- موضوع إلى جنبه على «المشجب»، وهو عيدان أو خشبات تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب، فصلى بهم جابر رضي الله عنه إماما في تلك الصلاة التي حضرت، وبعد الصلاة طلب منه محمد بن علي بن الحسين أن يخبره عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وتسمى حجة الوداع، فأشار جابر رضي الله عنه بيده وضم تسعا من أصابعه، حيث كان العرب يستعملون الأصابع في الحساب، فكأنه أراد عد الأرقام من واحد إلى تسعة، ثم أخبر جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل تسع سنين في المدينة بعد الهجرة لم يحج، ثم في السنة العاشرة بعد الهجرة أمر بالنداء في الناس وإعلامهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، وذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكبر عدد من أصحابه رضي الله عنهم؛ ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام، ويشهدوا أقواله وأفعاله، ويوصيهم؛ ليبلغ الشاهد الغائب، وتشيع دعوة الإسلام، ولم يقتصر النداء على أهل المدينة، بل تعدى إلى جميع أنحاء الأمصار والبلدان، وعلى إثر هذا النداء، جاء المدينة الكثير من الناس، كلهم يبتغي ويريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله في الحج؛ لأنه القدوة الحسنة
ويخبر جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا معه وقد بقيت خمس ليال من شهر ذي القعدة كما في رواية النسائي، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قد خرج من المدينة نهارا بعد أن صلى الظهر أربعا بالمدينة، وخرج بين الظهر والعصر، حتى نزل بذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غير أهلها، وهي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة (10 كم تقريبا)، وتسمى اليوم عند العامة أبيار علي أو آبار علي، وتبعد عن مكة حوالي 420 كيلومترا
وفي هذا المكان ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ابنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: كيف تصنع في إحرامها بعد أن نفست؟ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للنظافة؛ لأن دم النفاس لا ينقطع إلا بعد انقطاع مدة النفاس، ولذلك أمرها بقوله: «واستثفري»، والاستثفار هو جعل ثوب أو خرقة على محل الدم -الفرج- يمنع من نزول الدم، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالنية والتلبية، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف؛ لما رواه النسائي وابن ماجه عن أبي بكر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «وتصنع ما يصنع الناس» من الذكر والتلبية، وتقف بمنى وعرفات والمزدلفة، «إلا أنها لا تطوف بالبيت»، أي: لا تطوف بالكعبة المشرفة طواف الركن إلا بعد أن تطهر من النفاس، ثم تطوف
ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين للظهر، وتلك الصلاة كانت قبل انصرافه صلى الله عليه وسلم من الميقات وبعد الإحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصوله ذي الحليفة صلى فيها العصر ركعتين، ثم صلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر، فيكون صلى فيها خمس صلوات، وجلس يوما وليلة، ولعل جلوسه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى يتوافد الناس إليه، وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته؛ لأن الحج يبدأ من الميقات حيث يكون الإحرام منه
ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء -وهو اسم ناقته التي يرتحل عليها- حتى إذا استوت -أي وقفت قائمة- به ناقته على «البيداء»، والبيداء في اللغة هي الصحراء لا شيء بها، والمقصود بها هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وهو فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، وفي أول البيداء بئر ماء، يخبر جابر رضي الله عنه أنه نظر إلى منتهى بصره بين يديه، فإذا الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الراكب والماشي، وأمامه ويمينه، وشماله وخلفه، وكلام جابر رضي الله عنه كناية عن كثرة الناس وحضورهم، وبيان لمدى ما عندهم من حرص أن يستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله صلى الله عليه وسلم فعلوه، فهم يتابعونه ويسيرون على نهجه، وعلى طريقته، ثم بين جابر رضي الله عنه أن الناس يفعلون ذلك لإيمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه القرآن، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يعلم تفسيره وبيان معناه ومقاصده، ومن ذلك أعمال الحج والعمرة
ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته بكلمة التوحيد، فقال: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ومعناها: أكرر إجابتي لك في امتثال أمرك بالحج، فأنت المستحق للشكر والثناء؛ لأنك المتفرد بالكمال المطلق، ولأنك المنعم الحقيقي، وما من نعمة إلا وأنت مصدرها، وأنت المتفرد بالملك الدائم، وكل ملك لغيرك إلى زوال. والحكمة من التلبية: هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده؛ بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه. وفي هذا مخالفة لما كان يقوله المشركون في الجاهلية في تلبيتها من لفظ الشرك، فكانوا يقولون: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك» كما في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال جابر رضي الله عنه: «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به»، يعني: أنهم لم يلتزموا هذه التلبية الخاصة التي لبى بها صلى الله عليه وسلم، ويوضح هذا ما روي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي، لا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه»، وما ورد في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي بمثل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد فيها: «لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل»، وقد ورد غير هذا مما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ فهموا أنها ليست متعينة، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا منها، وكان يسمعهم، ولا ينكر عليهم، وسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار منه على ما يلبون به
وأخبر جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على تلبيته ولزمها، ثم قال جابر رضي الله عنه: «لسنا ننوي إلا الحج» كان هذا في أول الأمر، وقت خروجهم من المدينة، وإلا فقد أحرم بعضهم بالعمرة، أو هو خبر عما كان عليه حال غالبهم، أو أن المقصد الأصلي من الخروج كان الحج، وإن نوى بعض العمرة، ثم قال جابر: «لسنا نعرف العمرة» هذا يحتمل أن يخبر به عن حالهم الأول قبل الإحرام؛ فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما كان عند الإحرام بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين: «من أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل»، فارتفع ذلك الوهم الواقع بهم، وظلوا كذلك
فلما حضروا إلى مكة -وكان حضورهم صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة- أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكعبة، فاستلم صلى الله عليه وسلم الركن، ويقصد به: الحجر الأسود، واستلامه يشمل مسحه وتقبيله، ثم بدأ الطواف بالبيت فطاف بالبيت سبعة أشواط، أسرع صلى الله عليه وسلم المشي مع تقارب الخطى في أول ثلاثة أشواط منهم، ومشى مشيته العادية في الأربعة الأخرى، ويبدأ الشوط من أمام الحجر الأسود وينتهي عنده
ثم بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه حول الكعبة توجه إلى مقام إبراهيم، فقرأ قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125]، أي: اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلى تصلون عنده؛ عبادة منكم لله تعالى، وتكرمة لإبراهيم عليه السلام من الله سبحانه، وذلك عقب الانتهاء من الطواف بالكعبة؛ فيكون المقام بين البيت وبين المصلي، ومقام إبراهيم هو موضع قيامه، وهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وفيه أثر قدمه عليه السلام، ومكانه معروف الآن إلى جانب الكعبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت، فصلى خلف المقام، استجابة لأمر الله تعالى
ويخبر جعفر بن محمد أن أباه محمدا روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هاتين الركعتين سورة: {قل يا أيها الكافرون} في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة: {قل هو الله أحد}، كما في سنن الترمذي والنسائي، فالرواية هنا ليس مقصودا منها الترتيب
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود مرة أخرى، فاستلمه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا، وخروجه صلى الله عليه وسلم منه؛ لأنه أقرب الأبواب إلى جبل الصفا، ولأن الصفا والمروة كانتا حينئذ خارج المسجد، فلما قرب من جبل الصفا قرأ قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، وقال: «أبدأ بما بدأ الله به» يعني: أن الله تعالى بدأ بالصفا في الذكر، فنحن نبدأ بها فعلا وعملا، وسمي الصفا؛ لأن حجارته من الصفا، وهو الحجر الأملس الصلب، ويقع في أصل جبل أبي قبيس، فبدأ صلى الله عليه وسلم في سعيه بالصفا، فصعد على جبل الصفا، حتى رأى الكعبة المشرفة، فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده» منفردا بالألوهية، أو متوحدا بالذات، «لا شريك له» في الألوهية، ولا في الصفات، «له الملك وله الحمد»، أي: كل شيء ملكه، وله التصرف في ملكه كيف يشاء، وله العظمة، وله الثناء الجميل والشكر العميم على نعمائه وفضله، «وهو على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء؛ فله سبحانه وتعالى القدرة الكاملة، «لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده»، أي: وفى بما وعده بإظهاره عز وجل للدين، «ونصر عبده» والمراد: نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا، «وهزم الأحزاب وحده»، أي: هزمهم بغير قتال من الآدميين، ولا بسبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب: هم الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق سنة خمس من الهجرة، وقال هذا الذكر ثلاث مرات، ودعا بما فتح الله عليه بعد كل مرة
ثم نزل ماشيا إلى المروة، حتى إذا انحدرت قدماه واتجهت إلى أسفل «في بطن الوادي»، والمراد به المنخفض الذي بين الجبلين، «سعى»، أي: أسرع في مشيته، حتى إذا ارتفعت قدماه واتجهت إلى أعلى مشى على عادة مشيه، حتى أتى صلى الله عليه وسلم وصعد جبل المروة، وهو مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام، ففعل صلى الله عليه وسلم على المروة مثل ما فعل على الصفا من استقبال القبلة، والذكر والدعاء، وكان سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وقد وضح وعلم الآن مكان سعيه صلى الله عليه وسلم بمصابيح خضراء معلقة في سقفه على طول المسافة التي كان يسعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم
حتى إذا كان في آخر طوافه -وهو الشوط السابع الذي ينتهي إلى المروة- قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت في آخره من جواز العمرة في أشهر الحج، ما سقت الهدي معي من خارج مكة ولكنت متمتعا؛ أراد المخالفة لأهل الجاهلية في اعتقادهم وأفعالهم، فوجود الهدي مانع من فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منها، والأمر الذي استدبره صلى الله عليه وسلم هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه بالفسخ، حتى إنهم توقفوا وترددوا وراجعوه، بخلاف من لم يسق معه هديا، فإنه يفسخ الحج إلى عمرة. وكان هذا القول: «لو استقبلت...» تطييبا لأصحابه الذين أمرهم بأن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة؛ لأنهم لم يسوقوا معه الهدي، وهو اسم لكل ما يهدى إلى البيت من الأنعام الإبل والبقر والغنم؛ قربة إلى الله عز وجل، ودل أيضا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد، وأنه في حالة سوق الهدي يبقى القارن والمفرد على إحرامه حتى يوم النحر
وسأل سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «ألعامنا هذا أم لأبد؟»، أي: هل جواز فسخ الحج إلى العمرة، أو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، أو مع الحج يختص بهذه السنة أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقال: «دخلت العمرة في الحج»، أي: حلت العمرة في أشهر الحج، قال ذلك مرتين، ثم قال: «لأبد الأبد»، فهذا حكم عام في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج في كل الأعوام بدون اختصاص أحدها
وأخبر جابر رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن بهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن قبل حجته قاضيا وقابضا للصدقات، فرجع، وكان قد أهل في الطريق ونوى الدخول في النسك، ولما دخل علي رضي الله عنه مكة -وكان لم يعلم بعد بالتمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم- فوجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حل ولبست ثيابا «صبيغا»، أي: مصبوغا بما لا يحل للنساء لبسه في الإحرام، ووضعت الكحل بعينها، وهذا كله كناية عن كامل زينتها وإحلالها من الإحرام، فأنكر ذلك عليها؛ ظنا أنه لا يجوز، فأخبرته أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بفسخ الإحرام، فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «محرشا» على فاطمة رضي الله عنها، والتحريش: الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وأنه أنكر عليها ما فعلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقت صدقت» يقر له صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبرته به فاطمة رضي الله عنها
ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا قلت حين فرضت الحج؟»، أي: بأي شيء نويت حين أحرمت: بحج، أو عمرة، أو بهما؟ فأخبره علي رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أهل بما أهل به رسولك»، أي: أحرم بما أحرم به رسولك، فقال صلى الله عليه وسلم: «فإن معي الهدي» بيان لسبب عدم إحلاله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه أيضا ساق الهدي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إهلاله، وأمره أن يبقى على إحرامه
ثم أخبر جابر رضي الله عنه أن مجموع الهدي من الإبل الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به صلى الله عليه وسلم من المدينة؛ مائة
وقد تحلل الذين لم يسوقوا الهدي استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصروا شعر رأسهم، وأقاموا محلين يباشرون أعمالهم التي حرمت عليهم بالإحرام، وقوله: «وقصروا» مع أن الحلق أفضل من التقصير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في ذلك: حتى يبقى شعر إلى نسك الحج يحلق يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلم يتحللوا من إحرامهم، فلما كان يوم التروية -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لأن الماء كان قليلا بمنى، فكانوا يرتوون من الماء ويحملونه لما بعد ذلك- توجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى، فأما المتمتعون فإنهم أحرموا إحراما جديدا لحجهم، وأما الذين كانوا قارنين -وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي- فبقوا على إحرامهم. والإهلال يكون في المكان الذي ينزل فيه الإنسان، والصحابة كانوا نازلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فأحرموا منه، كما في الصحيحين. ومنى واد تحيط به الجبال، تقع في شرق مكة، على الطريق بين مكة وجبل عرفة، وتبعد عن المسجد الحرام نحو 6 كم تقريبا، ومنى: موضع من شعائر الحج، ومبيت الحجاج في يوم التروية، ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وفيها موقع رمي الجمرات، والتي تتم بين شروق وغروب الشمس في تلك الأيام من الحج ويذبح فيها الهدي
وأخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حين طلوع الشمس من يوم التروية، فصلى بمنى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، كل صلاة لوقتها. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الفجر قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بضرب خيمة تصنع له، وهي تصنع من الشعر، والمراد به: شعر الماعز وصوف الغنم، «بنمرة» قبل قدومه إلى عرفة، وتقع نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب مسجد نمرة في وادي عرنة
فسار صلى الله عليه وسلم وأصحابه من منى إلى جبل عرفة، وهو جبل خارج حدود الحرم على الطريق الذي يربط بين مكة والطائف، حيث يقع شرقي مكة بنحو 22 كم، وعلى بعد 10 كم من منى، و6 كم من مزدلفة، وإجمالي مساحته تقدر بحوالي 10,4 كم، وكانت قريش لا تشك في أنه سيقف عند «المشعر الحرام»، وهو جبل في المزدلفة، يقال له: قزح، ويقع فيه مسجد المشعر الحرام في بداية مزدلفة، وكان بعض الناس من قريش يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفعل كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، وفي رواية لمسلم: أن العرب في الجاهلية كان الذي يدفع بهم في الحج رجل يقال له: "أبو سيارة"، وهو رجل من بني بجيلة يدعى عميرة بن الأعلم، يركب على حمار ليس عليه برذعة، وليس عليه شيء تحت الراكب يجلس عليه، فيدفع من المزدلفة ولا يخرج إلى عرفات
فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات مباشرة، حتى قاربها ووجد القبة قد ضربت بنمرة، فنزل بها، وظل بها، حتى إذا مالت الشمس وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب، أمر بإحضار ناقته القصواء، فشد على ظهرها الرحل ليركبها صلى الله عليه وسلم، فركبها، فأتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو أحد أودية مكة المكرمة، يقع غرب عرفات، ويخترق أرض المغمس، فيمر بطرف عرفة من جهة الغرب عند مسجد نمرة، ثم يجتمع مع وادي نعمان، ويمر جنوب مكة على حدود الحرم، وفي هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، ووعظهم، وقال: «إن دماءكم وأموالكم»، أي: إن سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغير حق، «حرام عليكم» متأكد تحريمها، كحرمة يوم عرفة، وحرمة شهر ذي الحجة، وحرمة مكة، وهذا من التشديد والتغليظ
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية» يعني: الذي أحدثوه، والشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام، والجاهلية: هي المدة التي كان الناس فيها على الشرك قبل مجيء الإسلام، وسميت بها لكثرة جهالاتهم. «تحت قدمي موضوع»، أي: باطل ومهدر، ولا يؤخذ به، «ودماء الجاهلية موضوعة»، أي: متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن أول دم أضعه وأتركه من دمائنا -كونه صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه- دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قصاص فيه، ولا دية فهو هدر؛ لأنه من دماء الجاهلية، «وكان مسترضعا»، أي: كان لهذا الابن حاضنة ترضعه من بني سعد، فقتلته قبيلة هذيل
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وربا الجاهلية»، والربا حرام في الجاهلية والإسلام، وإنما نسبه إلى الجاهلية؛ لأنهم أحلوه لأنفسهم، فلما جاء الإسلام أثبت حرمته، والربا هو التعامل بين الناس بالزيادة على أصل الديون والإقراض، سواء كان ربا الزيادة والفضل، أو ربا التأجيل والنسيئة، وقد حرمه الله تعالى وتوعد عليه؛ فقال تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275]، وقوله: «موضوع»، أي: باطل وهدر، فكل المعاملات الربوية التي سبقت في الجاهلية وبقي منها شيء، فهو هدر، والمراد بوضعه؛ وضع الزائد منه، لا وضع رأس المال، فإنه مردود لصاحبه، كما قال تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} [البقرة: 279]. «وأول ربا أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله»، وبدأ بربا عمه العباس رضي الله عنه؛ لخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ليقتدي الناس به قولا وفعلا، فيضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك
ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال: «فاتقوا الله في النساء»، أي: خافوا عقوبة الله تعالى في ترك القيام بحقوق الزوجات ومصالحهن الدينية والدنيوية، بإنصافهن ومراعاة حقهن؛ «فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»، أي: تزوجتم بهن بشرع الله، وجعل الله لكم عليهن حق الوطء، فبهذا هن أمانات عندكم، فعليكم أن تقوموا برعاية هذه الأمانة، وعدم الإضرار بهن، وعدم الإساءة إليهن، وإنما تحسنون إليهن، وتعاشرونهن بالمعروف، والمراد بكلمة الله العقد الذي ينشأ من كلمتي إيجاب وقبول من الولي والزوج
فلما أوصى بالنساء ذكر ما عليهن من الحقوق، فقال: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه»، أي: تكرهون دخوله في بيوتكم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء، الأقرباء والأجانب، وقيل: لا يفهم من هذا الكلام أنه النهي عن الزنا؛ فإن ذلك محرم مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه، «فإن فعلن ذلك» فأدخلن بيوتكم من تكرهون دخوله بدون رضاكم، فلكم معشر الرجال أن تؤدبوهن وإن تعدى هذا التأديب إلى الضرب، «فاضربوهن ضربا غير مبرح»، أي: ليس بشديد ولا شاق، وأخبر صلى الله عليه وسلم ما على الرجال لأزواجهن من الحقوق، فلهن النفقة من المأكول، والمشروب، والسكنى، والملبس على قدر كفايتهن، من غير سرف ولا تقتير، أو باعتبار حالكم فقرا وغنى
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وقد تركت فيكم»، أي: فيما بينكم، وهذا الكلام موجه لجميع المسلمين، سواء لمن حضره في تلك الحجة، أو من غاب عنها في زمنه، أو من سيأتي بعده في الأزمان التالية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتاب الله، وهو القرآن العظيم؛ فهو سبب رئيسي في حفظ الإنسان من الضلال، سواء من ضلالات الكفر والنفاق والخروج من الدين، أو من ضلالات الزلل والوقوع في المعاصي واتباع الشهوات، وذلك مشروط بقوله: «إن اعتصمتم به» بمعنى: إن تمسكتم به، ولم يذكر السنة؛ لأن القرآن مشتمل على العمل بها، وذلك في قول الله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} [المائدة: 92]، فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة
ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لأصحابه رضي الله عنهم: «وأنتم تسألون عني»، أي: عن تبليغي رسالات الله وشرعه ودعوتي فيكم يوم القيامة، «فما أنتم قائلون؟» استنطقهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابتهم لله عز وجل يوم القيامة؛ قال تعالى: {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} [الأعراف: 6]، فقال الصحابة رضي الله عنهم: «نشهد أنك قد بلغت»، أي: رسالات ربك وجميع ما أمرك به وما أنزله عليك، «وأديت» الأمانة، «ونصحت» الأمة، فأشار بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء «وينكتها إلى الناس» وفي رواية أبي داود: «ينكبها»، والمراد يميلها إليهم، يريد بذلك أن يشهد الله عليهم، ويقول: «اللهم اشهد»، أي: على عبادك، بأنهم أقروا بأني قد بلغت، وكرر قوله: «اللهم اشهد» ثلاث مرات للتأكيد عليهم
ثم أذن بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام فصلى ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين، ولم يصل بينهما شيئا، فجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولم يصل بينهما شيئا من السنن والنوافل، وذلك للاستعجال بالوقوف، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء -وهو اسم ناقته التي يرتحل عليها- وسار حتى أتى الموقف الخاص به في أرض عرفات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني أنه علا على الصخرات ناحية منها، حتى كانت الصخرات تحاذي بطن ناقته، والصخرات هي الأحجار الكبار المغروسة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. «وجعل حبل المشاة»، وهو المستطيل من الرمل، والمراد به صف المشاة ومجتمعهم في مشيهم كحبل الرمل «بين يديه»، أي: أمامه مستقبلا القبلة في الوقوف بعرفة، كل ذلك يدعو ويناجي الله عز وجل، فوقف في عرفة حتى غربت الشمس وذهبت صفرة الشمس ذهابا قليلا، حتى غاب قرص الشمس، أي: تحقق الغروب، وهو وقت الانصراف من عرفة، فأركب أسامة بن زيد رضي الله عنه خلفه على الدابة، وابتدأ في التحرك والسير، وقد «شنق»، أي: ضم وضيق للناقة الزمام، فضم رأسها إليه، وبالغ في الضم حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب، يريد بذلك أن يمنعها من الحركة والسرعة والإقدام في المشي، ويشير بها بيده اليمنى ويقول: «أيها الناس، السكينة السكينة»، أي: الزموا الرفق والطمأنينة، وعدم التزاحم، وكلما أتى حبلا من الحبال -وهو الموضع المتسع من الرمال المرتفع مثل التل اللطيف من الرمل الضخم- أرخى للقصواء الزمام إرخاء قليلا، أو زمانا قليلا، حتى يسهل عليها الصعود، وظل صلى الله عليه وسلم كذلك حتى أتى المزدلفة، وهي المشعر الحرام، وكلها من الحرم، وهي المكان الذي ينزل فيه الحجيج بعد الإفاضة من عرفات ويبيتون فيه ليلة العاشر من ذي الحجة، فصلى بها المغرب والعشاء، أي جمع بينهما في وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين مرة للمغرب ومرة للعشاء، ولم يصل بين المغرب والعشاء شيئا من النوافل والسنن، ثم اضطجع للنوم تقوية للبدن، ورحمة للأمة؛ لأن في نهاره أعمالا وعبادات يحتاج فيها إلى النشاط، واستيقظ صلى الله عليه وسلم مع طلوع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقته، وهذا بعد صلاته ركعتي السنة
ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة، وسمي حراما؛ لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم، أو لأنه ذو حرمة. وسمي مشعرا؛ لأنه معلم للعبادة، فاستقبل صلى الله عليه وسلم الكعبة، فدعا الله «وكبره»، أي: قال: الله أكبر، «وهلله»، أي: قال: لا إله إلا الله، «ووحده»، أي قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلم يزل واقفا حتى أضاء الفجر إضاءة تامة، فذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما خلفه على الدابة، وكان رجلا حسن الشعر، أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به «ظعن» وهن: النساء «يجرين»، أي: يسرعن في سيرهن، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يمنعه من النظر إليهن، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر؛ لأن النساء كانت من حولهم، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى جاء بطن محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، فحرك ناقته، وأسرع السير قليلا، وفي منى ثلاث طرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: شرقي، وغربي، ووسط، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وإنما سلكها لأنها كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي عند الشجرة، غربي منى مما يلي مكة، فرماها صبيحة يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، «مثل حصى الخذف» والمراد بيان مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبر، والمراد أنها تكون بقدر حبة الباقلاء، وقد رمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، فكانت مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم رجع عن جمرة العقبة إلى موضع النحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى بقية البدن عليا رضي الله عنه، فنحر علي ما بقي من المائة، وأشركه صلى الله عليه وسلم في نفس الهدي، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة من المائة بقطعة من لحمها، فجعلت القطع في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشربا من مرقها، وإنما فعل هذا ليمتثل قوله تعالى: {فكلوا منها} [البقرة: 58]، وهما وإن لم يأكلا من كل بضعة، فقد شربا من مرق كل ذلك، وخصوصية علي رضي الله عنه بالمؤاكلة دليل على أنه أشركه في الهدي
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى بيت الله ليطوف به طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، فصلى الظهر بمنى»، ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم دخل وقت الظهر، فصلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه للصلاة معه، فصلى بهم مرة أخرى، حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طواف الإفاضة على بني عبد المطلب، وهم أولاد العباس وجماعته؛ لأن سقاية الحاج كانت وظيفتهم، فمر عليهم وهم ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون الناس، فيغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: «انزعوا»، أي: استقوا الماء للحجاج، «فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، لنزعت معكم»، أي: لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، فأعطوه فشرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم
وفي الحديث: أن من هديه صلى الله عليه وسلم الحج راكبا
وفيه: الحث على مراعاة حق النساء، والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف
وفيه: الأمر بالنفقة على الزوجة
وفيه: فضل أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عنهم
وفيه: السكينة في الدفع من عرفات
وفيه: أن عرفة كلها موقف.
وفيه: الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة
وفيه: عدم التنفل بين الصلوات في الجمع
وفيه: الاستنابة في ذبح الهدي
وفيه: الشرب للناسك من ماء زمزم، والإكثار منه
وفيه: حرص المؤمنين على الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم