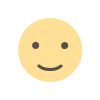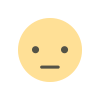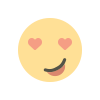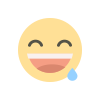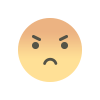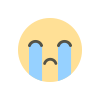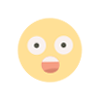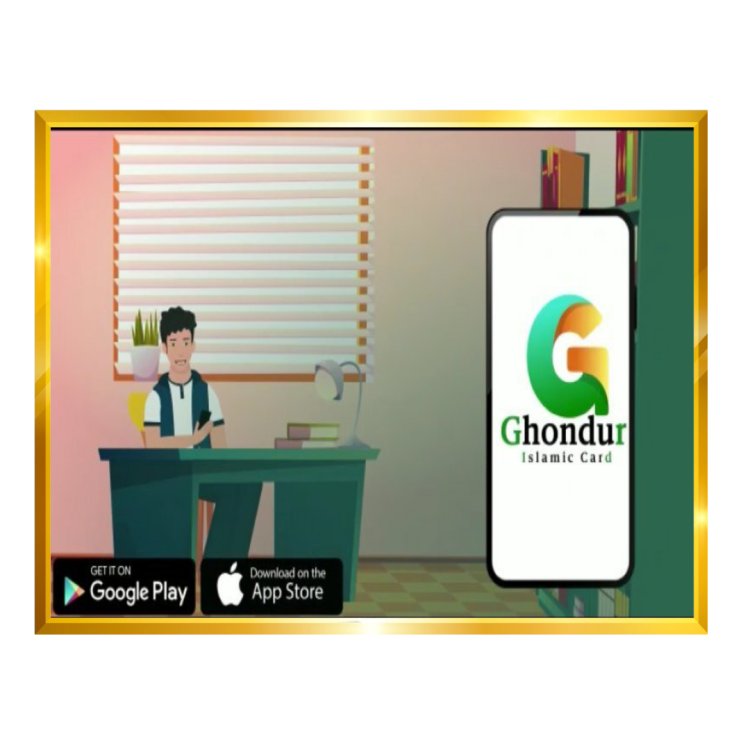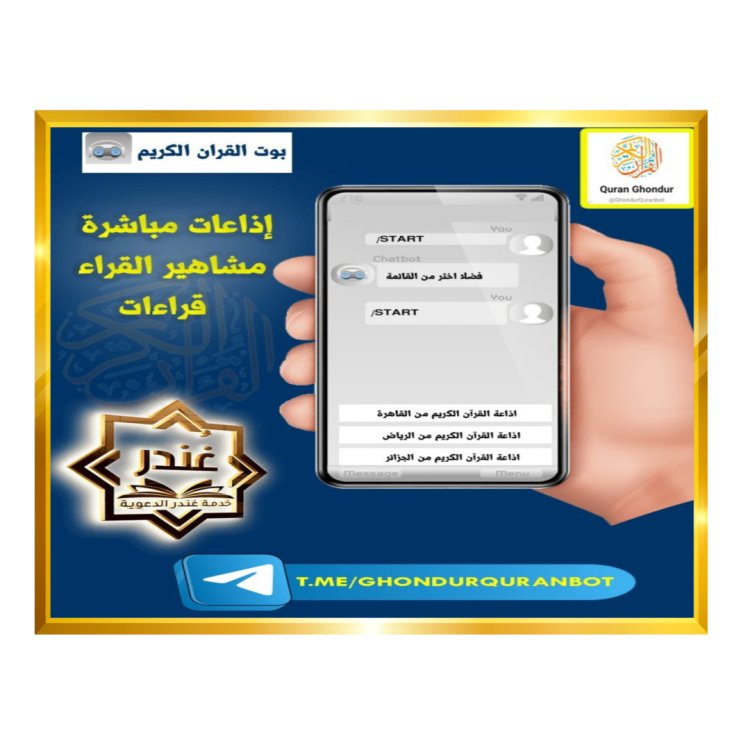الحلف بالطواغيت
سنن النسائي
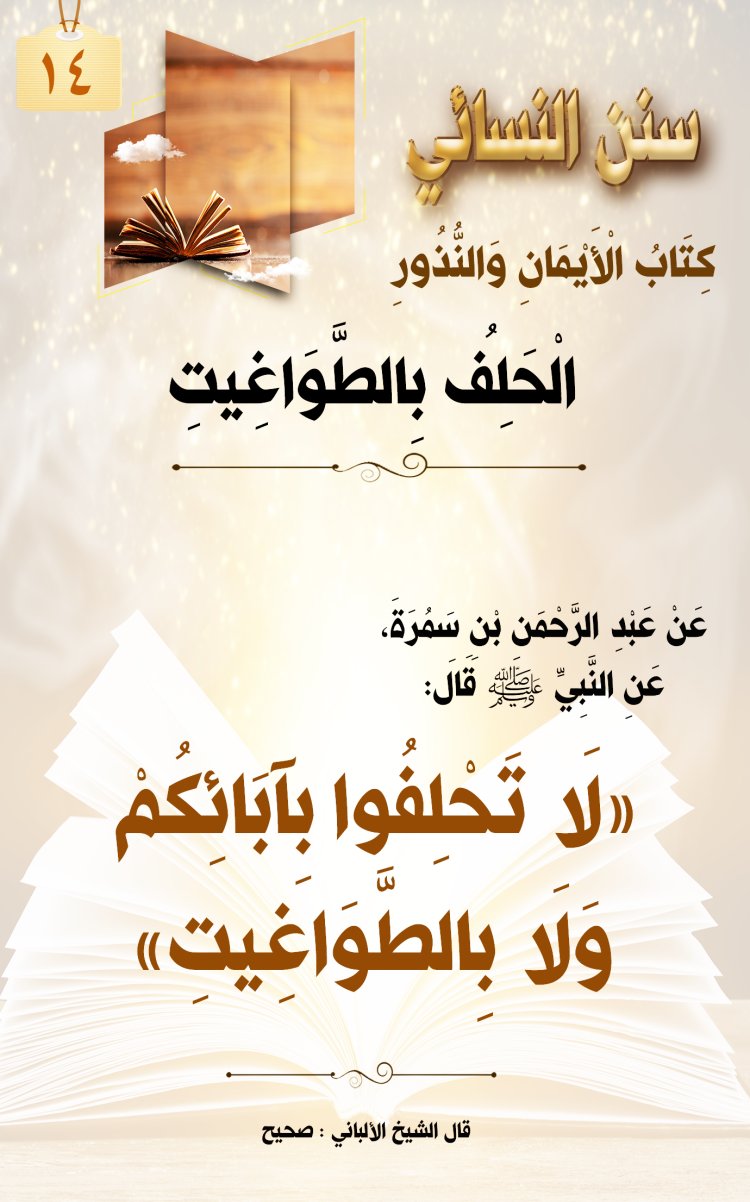
أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»

كان مِن عادةِ العربِ أنْ يَحلِفوا بآبائِهم أو بآلهتِهم وغيرِها ممَّا كان يَعبُدونَه أو يُعظِّمونَه في الجاهليَّةِ، والحلِفُ بالشَّيءِ تَعظيمٌ له؛ ولذلك نَهى اللهُ سُبحانَه وتَعالَى عَن الحلِفِ بغَيرِه؛ لأنَّ حَقيقةَ العَظَمةِ مُختصَّةٌ باللهِ تعالَى، فلا يُساوَى به غيرُه؛ ولهذا وجَبَ أنْ يكونَ حَلِفُنا باللهِ أو بأسمائِه وصِفاتِه؛ حتَّى لا نقَعَ في الشِّركِ الأصغَرِ
وفي هذا الحديثِ يَنْهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الحلِفِ «بِالطَّواغِي» جمْعُ طاغيةٍ، وهي الأصنامُ، الَّتي كان المشْرِكون يَعبُدونَها مِن دُونِ اللهِ، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها سَببُ الطُّغيانِ، ويَنْهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الحَلِفِ بِالآباءِ؛ فمَنْ أرادَ الحلِفَ فَلْيحلِفْ بِاللهِ، وإلَّا فَلْيصمُتْ ولا يَحلِفْ بِغيرِه، كما جاء في الصَّحيحينِ، وقدْ نَهَى عَنه الشَّرعُ؛ لأنَّه ذَريعةٌ إلى الشِّركِ الأكبرِ، ووَسِيلةٌ للوُقوعِ فيهِ، والشِّركُ الأصغرُ لا يُخرِجُ مَن وقَعَ فيهِ مِن مِلَّةِ الإسلامِ، ولكنَّه مِن أكبرِ الكبائرِ بَعدَ الشِّركِ الأكبرِ
وبيَّن لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -كما في الصَّحيحينِ- أنَّ مَن سَبَق لِسَانُه بذلك، فَلْيقُلْ مُستَدرِكًا على نَفسِهِ: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»؛ تبرُّؤًا مِن الشِّركِ؛ فيَشهَدُ للهِ بالتَّوحيدِ؛ لأنَّه بقَسَمِه أولًا بغيرِ اللهِ قَد ضاهى بِحَلِفِه الكُفَّارَ، حَيثُ أشرَكَ ما حلَفَ به مع اللهِ في التَّعظيمِ، فتكونُ الشَّهادةُ نفْيًا لتَعظيمِ ما حلَفَ بهِ