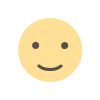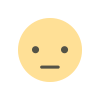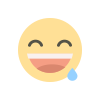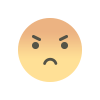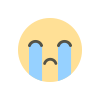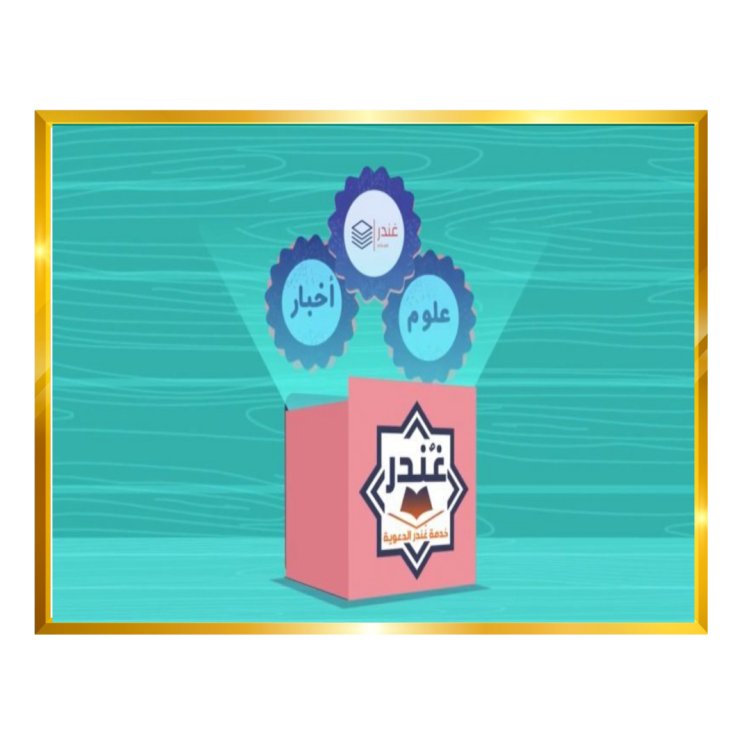باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، بدأ بي؛ فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمرى أبويك، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت، ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال (يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) إلى (أجرا عظيما) قالت: فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة؛ قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت

ربما كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من يقع منها في حقه صلى الله عليه وسلم مثل ما يقع من النساء في حق أزواجهن من الغيرة والمضايقات وما شابه
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان حريصا على أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]. و«صغت»، أي: مالت وانحرفت عن الواجب، والمعنى: إن تتوبا إلى الله، فلتوبتكما موجب أو سبب؛ وهو أن قد مالت قلوبكما عن الحق، وانحرفت عما يجب عليكما نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ من كتمان لسره، وحرص على راحته، واحترام لكل تصرف من تصرفاته
فظل ابن عباس رضي الله عنهما حريصا على ذلك، إلا أنه من هيبته لعمر ما استطاع أن يسأله حتى جاءت الفرصة عند خروجهم للحج؛ وكان ابن عباس في رفقته، ويحكي ابن عباس رضي الله عنهما أنه في أثناء عودتهم بعد انقضاء حجهم، أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جانبا عن الطريق المسلوكة إلى طريق لا تسلك غالبا؛ ليقضي حاجته من البول والغائط، وذهب معه ابن عباس بالإداوة -وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء- فقضى عمر رضي الله عنه حاجته، فلما جاء سكب ابن عباس على يديه الماء من الإداوة فتوضأ، ثم سأله عقب وضوئه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين نزلت فيهما الآية، فتعجب عمر رضي الله عنه من ابن عباس كيف خفي عليه هذا الأمر مع شهرته بينهم بعلم التفسير؟ وإما لأنه رأى في سؤاله حرصا لا يتنبه له إلا الحريص على العلم من تفسير ما أبهم في القرآن. وقيل: قال عمر ذلك تعجبا، كأنه كره ما سأله عنه. وأجابه إلى ما سأل بأن المرأتين هما أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما
ثم شرع عمر رضي الله عنه يروي الذي حدث؛ فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار -وهو: أوس بن خولى بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه- نسكن في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، أي: القرى التي بقربها من جهة نجد على بعد ثلاثة أو أربعة أميال من المدينة، وكنا نتبادل الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فينزل هو يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الوحي أو الأوامر الشرعية وغير ذلك من الحوادث الكائنة عنده صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل جاري فعل مثل ذلك
قال: وكنا -معشر قريش- نغلب النساء، أي: نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، فلما قدمنا على الأنصار -وهم أهل المدينة- إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فليس لهم شدة وطأة وحكم عليهن، فصارت نساء المهاجرين يأخذن من أدب نساء الأنصار، أي: من سيرتهن وطريقتهن مع أزواجهن، فرفعت صوتي على امرأتي يوما، فردت علي الجواب، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر علي أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وفي رواية أخرى في الصحيحين قالت: وإن ابنتك -تعني: أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها- لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، فأفزعني كلامها، فقلت: خابت وخسرت من فعلت منهن ذلك، وقد أتت بأمر عظيم
ثم أخبر عمر رضي الله عنه أنه لبس ثيابه، ثم ذهب رضي الله عنه إلى ابنته حفصة، فلما دخل عليها سألها: أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فأجابت: نعم يحدث ذلك. فقال عمر: خابت وخسرت من غاضبته؛ أفتأمن التي تغاضبه منكن أن يغضب الله عليها لغضبه صلى الله عليه وسلم؟! فتهلكين بهذا. وأوصاها رضي الله عنه بألا تطلب منه صلى الله عليه وسلم الكثير، ولا تراجعه في شيء، ولا تهجره ولو هجرها، وأن تسأل عمر ما بدا لها، أي: تطلب منه كل ما تريده وتحتاجه، ثم قال: ولا يغرنك كون جارتك -أي: ضرتك، والعرب تطلق على الضرة جارة؛ لتجاورهما المعنوي، ولكونهما عند شخص واحد- هي أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. والمعنى: إياك أن تغتري بكون عائشة رضي الله عنه تفعل ما نهيتك عنه، فلا يؤاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لاحتمال ألا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها
ثم يقول عمر: وكنا تحدثنا -أي: كان عندهم خبر- أن غسان -وهم قوم من قحطان، نزلوا حين تفرقوا من سد مأرب بماء يقال له: غسان، فسموا بذلك، وسكنوا بطرف الشام- تنعل النعال، أي: تصنع الحديد لأجل حوافر الخيل، وتعد خيلها ودوابها. يشير بذلك إلى تجهزهم لغزو المسلمين، فنزل صاحبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومه، فسمع اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، فرجع إلى العوالي عشاء، أي: في آخر يومه ونهايته، وضرب بابي ضربا شديدا، وقال: أنائم هو؟ يقول ذلك على سبيل الاستخبار؛ وذلك لبطء إجابته له، فظن أنه نائم. قال عمر رضي الله عنه: ففزعت، أي: خفت لأجل الضرب الشديد، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأزيد؛ طلق صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: «طلق» بالجزم، فيحتمل أن يكون الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق، فتناقله الناس، وأصله ما وقع من اعتزاله صلى الله عليه وسلم لنسائه بذلك، ولم تجر عادته بذلك، فظنوا أنه طلقهن
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد خابت حفصة وخسرت؛ كنت أظن أن هذا يوشك أن يحدث؛ لأن المراجعة قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة. وخص حفصة رضي الله عنها بالذكر لمكانتها منه؛ لكونها ابنته، ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك
فلبس عمر رضي الله عنه ثيابه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الفجر معه صلى الله عليه وسلم، ودخل صلى الله عليه وسلم مشربة له، أي: غرفة مرتفعة له يخزن فيها الطعام، فاعتزل فيها صلى الله عليه وسلم نساءه، فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟! أولم أكن حذرتك؟ يعني: من أن تغاضبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تراجعيه أو تهجريه. ثم استفهمها عما سمعه، فقال: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة، فخرج عمر إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا -دون العشرة من الرجال- يبكي بعضهم، فجلس معهم قليلا، قال: ثم غلبني ما أجد، أي: شغل قلبه ما بلغه من تطليقه صلى الله عليه وسلم نساءه، ومن جملتهن بنته، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى، فجئت المشربة التي هو صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت لغلام له أسود -اسمه رباح-: استأذن لعمر، فدخل فكلمه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج، فقال: ذكرتك له فصمت ولم يأذن في الدخول، فانصرف عمر وجلس مع الناس الذين عند المنبر، وكرر ذلك مرتين. فلما وليت منصرفا في المرة الثالثة، فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك صلى الله عليه وسلم في الدخول، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجع على رمال حصير، أي: على ما نسج من حصير، ليس بينه وبين الحصير فراش، قد أثر الرمال بجنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو متكئ على وسادة من أدم، أي: من جلد مدبوغ، حشوها ليف النخل، فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال: لا.
ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله -أي: أتبصر هل يعود صلى الله عليه وسلم إلى الرضا، أو أقول قولا أطيب به قلبه وأسكن غضبه؟- لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، ثم حكى له ما حدث مع امرأته، فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له ما قاله لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك -يعني عائشة رضي الله عنها- هي أوضأ منك، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فجلس عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، ثم نظر عمر في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجلس فيها، فيقسم عمر: فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة –جمع: إهاب، وهو الجلد- وهذا كله كناية عن رثاثة هيئة المكان الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن فارس والروم -مملكتان عظيمتان في ذلك الزمن- وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال له على سبيل الإنكار: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! يعني: أأنت في شك في أن النعيم والسعة في الآخرة خير من النعيم والسعة في الدنيا؟! أولئك -أي: فارس والروم- قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، أي: عن جراءتي بهذا القول في حضرتك
واعتزل صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، ولم يفسر هنا الحديث الذي أفشته حفصة، وفي الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت عائشة وحفصة على أن أيتهما دخل عليها فلتقل له: أأكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فقال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا»، وقيل: السبب مجموع ما كان من أزواجه من إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حدثا بعينه
وكان صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أنا بداخل عليهن -أي: على نسائه- شهرا؛ من شدة غضبه عليهن حين عاتبه الله بقوله: {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} [التحريم: 1]
فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر –يعني: الذي آليت فيه- تسع وعشرون ليلة
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فأنزلت آية التخيير، والتي فيها يخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بين الطلاق والفراق، وأن يعطيهن متعة، وبين أن يبقين زوجات له ويصبرن معه على شدة العيش، وهي قول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} [الأحزاب: 28، 29]، فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. أي: لا بأس عليك في عدم التعجيل، أو «لا» زائدة، والمعنى: ليس عليك التعجيل حتى تستشيري أبويك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم ذكر لها الآيتين، فقالت عائشة رضي الله عنها: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشة: نريد الله ورسوله والدار الآخرة
وفي الحديث: فضيلة عمر رضي الله عنه
وفيه: زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الزهد، والاكتفاء بالقليل من العيش، وكونه من أخلاق النبيين
وفيه: أن متاع الدنيا لا يبقى، بخلاف نعيم الآخرة؛ فهو الذي له البقاء
وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها
وفيه: أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها أو ذوي الرأي من أهلها في أمر نفسها
وفيه: ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم إكراما لمن يضحك إليه
وفيه: الحرص على طلب العلم، والتناوب في العلم والاشتغال به
وفيه: فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها