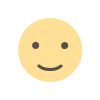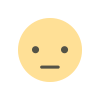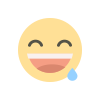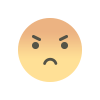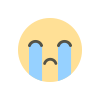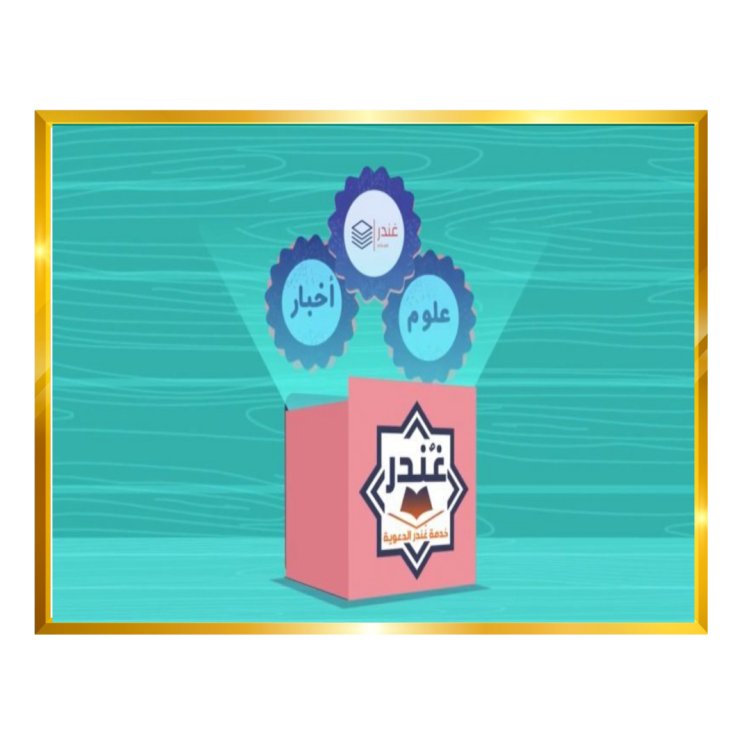باب فى الخلفاء

حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبى -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية فذكر الحديث. قال فأتاه - يعنى عروة بن مسعود - فجعل يكلم النبى -صلى الله عليه وسلم- فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى -صلى الله عليه وسلم- ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة.

كان صلح الحديبية فتحا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن نتائجه كانت مثمرة للإسلام والمسلمين، كما وقعت فيه أحكام من التيسير على المسلمين
وفي هذا الحديث يروي المسور بن مخرمة رضي الله عنه والتابعي مروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية هو وأصحابه في السنة السادسة من الهجرة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم -وكان خالد وقتذاك على الكفر، والغميم: واد بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، ويبعد نحو (60 كم) عن مكة المكرمة- في خيل لقريش طليعة، وهو من يبعث ليطلع على حال العدو، كالجاسوس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا ذات اليمين، فيتنحوا ويبعدوا عن الطريق التي فيها خالد وأصحابه، فلم يشعر بهم خالد، وفوجئ «بقترة الجيش»، أي: الغبار الأسود الذي أثارته حوافر خيل الجيش، فما كان من خالد إلا أن انطلق يركض نذيرا لقريش يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترابه من مكة، والمراد بالركض: ضرب الخيل بالأرجل على بطونها لاستعجالها في الإسراع، واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره، حتى إذا كان بالثنية -وهي ثنية المرار، وهي طريق في الجبل، وقيل: موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية، وهي طريقه المعتاد إلى مكة- بركت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الناقة التي يركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرك: جلوس البعير، فلما رأى الناس ما فعلت الناقة، قالوا: «حل حل» وهي كلمة تستعمل لزجر الجمل وحمله على المسير، ثم قالوا: «خلأت القصواء»، أي: وقفت وبركت وامتنعت من المشي، والقصواء: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصفة، وقال: «وما ذاك لها بخلق»، فليس امتناعها عن المشي لها بعادة، ولكن السبب أنها حبسها حابس الفيل، والمراد بالفيل: فيل أبرهة الحبشي الذي أتى به لهدم الكعبة، فمنعه الله من دخول مكة بجلوس الفيل، وهذا ما فعلته الناقة
ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش لن يسألوه أمرا يتفقون فيه على منع القتال تعظيما لمكة والكعبة، إلا وافق عليه؛ من أجل حرمة تلك الأماكن وعظمها عند الله، ثم زجر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة فوثبت، أي: قامت، فعدل عن اتجاه قريش وولى راجعا حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، والثمد: حفرة بها ماء قليل، وقوله: «يتبرضه الناس تبرضا»، أي: يأخذونه قليلا قليلا، ولم يبقوا من الماء شيئا، بل أخذوه كله، فشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه في تلك الحفرة -والكنانة: هي حافظة الأسهم- ففار الماء وارتفع في الحفرة حتى شربوا جميعا وارتووا، حتى إنهم صدروا عنه، أي: رجعوا عنه بعد أن قضوا حاجتهم منه وارتووا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته الشريفة
وبينما الناس على تلك الحالة إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه في نفر من قومه من خزاعة، وخزاعة: اسم قبيلة، ينسب إليها بديل بن ورقاء، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، والمراد بالعيبة: محل نصحه وموضع أسراره، وهم إن كانوا من خزاعة فهم أيضا من أهل تهامة، وتهامة: مكة وما حولها من البلدان، فقال بديل بن ورقاء: «إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت»، وذكر بديل لهذين الاسمين كناية عن أهل مكة؛ لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهما، والمراد بأنهم نزلوا أعداد مياه الحديبية: كثرة أعدادهم، أي: كثرة الماء الذي يتسع لهم مكان الحديبية، والعوذ المطافيل: الناقة التي معها ولدها، وقيل: هي النساء ومعها أولادها، وهو كناية عن استعدادهم لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصول إلى البيت ولو بالقتال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح لبديل أنهم لم يأتوا لقتال، ولكنهم أتوا إلى البيت الحرام معتمرين، وعلى قريش أن تخلي بينه وبين البيت خاصة، وأن قريشا قد نهكتهم الحرب، أي: أتعبتهم حتى بلغ بهم الضرر من تلك الحروب، فعلى قريش أن تختار بين أن يكون بيننا وبينهم صلح وهدنة زمنية يخلون فيها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من تبقى من كفار العرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن أظهر: فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا»، والجم: الراحة، والمراد: أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر على من بقي من كفار العرب وغلبهم؛ فإن شاءت قريش اتبعته كما اتبعه الناس، وإلا بقوا على صلحهم وهدنتهم معه، وهم في كلتا الحالتين يكونون قد استراحوا من جهد الحرب، ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا لو امتنعت وأبت ليقاتلنهم على ما جاء عليه فقال: «فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي»، فينفصل مقدم العنق، وهو كناية عن القتال حتى الموت، وأقسم أن الله لينصرن دينه ويظهره، فهو نافذ وماض على كل حال
فأجاب بديل بن ورقاء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ قريشا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه لهم، فأتى بديل قريشا وأبلغهم أنه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه منه مقالة، وخيرهم في عرضها عليهم، فرفض سفهاؤهم أن يخبرهم بشيء، وطلب ذوو الرأي منهم السماع، فحدثهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود بعد سماعه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى»، وهذا يدل على كمال الشفقة والمحبة التي تكون من الأب للابن، والنصح الذي يكون من الابن للأب، «قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» سوق بناحية مكة، والمراد باستنفارهم: دعوتهم إلى القتال نصرة لقريش. «فلما بلحوا علي» أي: امتنعوا، «جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى». وهذا خطاب يستجلب به موافقتهم على طلبه، ألا وهو: أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعجبته خطة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرضها بديل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يتكلم معه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إجابته لبديل بن ورقاء، فلما وجد عروة منه ذلك، قال: «أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك» ويقصد بقومه قريشا، «هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟!» والاستئصال، والاجتياح: هو القضاء عليهم وقطع دابرهم، ثم قال: «وإن تكن الأخرى، فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك»، والأشواب: الأخلاط من الناس ومن شتى القبائل، و«خليقا»، أي: حقيقا، والمراد: وإن كانت الغلبة لقريش، فما يلبث أن يتركك أتباعك ويفروا عنك، وهذا محقق فيهم؛ لأنهم من أخلاط الناس، فلما قال عروة كلمته تلك للنبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه أبو بكر رضي الله عنه قائلا: «امصص ببظر اللات؛ أنحن نفر عنه وندعه؟!»، والبظر: قطعة لحم بين شفري فرج المرأة، واللات: اسم لصنم من أصنام قريش، وهي كناية للعرب تستعمل لمن أراد أن يسب غيره، فأهان أبو بكر رضي الله عنه عروة في آلهته؛ ردا منه على إهانة عروة لهم بادعائه أنهم يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونه، فسأل عروة: من هذا؟ فقيل له: أبو بكر، فتذكره عروة وتذكر محسنة له معه، فلم يجبه ولم يرد على شتمه وسبه له، وقال: «لولا يد كانت لك عندي» ويقصد نوعا من الجميل والنعمة كان قدمها أبو بكر رضي الله عنه لعروة، «لم أجزك بها»، أي: لم أكافئك بها، «لأجبتك» أي: لكان الرد قاسيا، وجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته -جاريا على عادة العرب، وكانوا يستعملونه كثيرا، يريدون بذلك التحبب والتواصل- والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، وهو ما يوضع على الرأس تحت الخوذة ويسدل على الوجه ليحميه من ضربات السلاح، فلم يعرفه عروة، حتى إن عروة كلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب المغيرة يده بنعل السيف، يقول له المغيرة: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفه عروة تذكره وتذكر غدرته فقال له: «أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟!» وكان عروة عمه، وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، حتى إن عمه عروة ما زال يسعى في دفع فدية غدرته هذه، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلة المغيرة بقوله: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»، أي: وأما المال فلا نقبله لكونه مالا مغصوبا أتى بطريقة الغدر
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، وعد عروة بعض الملاحظات التي وجدها في علاقة الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: أنه ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، والنخامة: ما يخرج من الصدر إلى الفم، ومنها: ابتدارهم في أمره، وهو الإسراع في تلبية حاجاته صلى الله عليه وسلم، ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو الماء المتبقي منه، ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ومنها: أنهم كانوا رضوان الله عليهم ما يحدون إليه النظر تعظيما له، والإحداد: شدة النظر
فرجع عروة إلى قومه يخبرهم بما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم من محاورات ومباحثات، وأول ما بدأ في عرضه معهم هو شدة إعجابه وتعجبه بعلاقة الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قارن بين تلك العلاقة وعلاقة أصحاب الملوك بملوكهم في تعظيمهم لهم، كقيصر، وكسرى، والنجاشي، وبين لهم المفارقة بين هؤلاء وهؤلاء، وعرض بعض الصور المذكورة عليهم، ثم أكد لهم أن خطة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة خطة رشد، أي: فيها الصواب لقريش، فقال رجل من بني كنانة عقب انتهاء عروة من مقالته: «دعوني آتيه»، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوه، فلما أن اقترب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له»، أي: إنه صلى الله عليه وسلم عرفه وعرفه لأصحابه، ويقال هو: الحليس بن علقمة الحارثي، والمراد بتعظيمهم البدن: عدم استحلالهم للإبل أو البقر؛ لأنها مما يهدى إلى الحرم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها أمامه أن يؤكد له صدق نواياه وصدق خطته بأنهم أتوا معتمرين، ففعل الصحابة ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى ذلك استقبال الناس له وهم في حالة التلبية، فلما رأى الرجل هذا المشهد قال متعجبا: «سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت»، أي: ما ينبغي لأحد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء عمرتهم، فرجع إلى قومه؛ ليعرض عليهم ما رأى قائلا: «رأيت البدن قد قلدت وأشعرت»، وتقليد البدن: أن يعلق شيء في عنقها، وإشعارها: أن يجعل على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي
ثم طلب مكرز بن حفص من قريش أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا، فلما أن اقترب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا مكرز، وهو رجل فاجر»، وجعل يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم على تلك الحالة إذ أتاه سهيل بن عمرو، فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: «لقد سهل لكم من أمركم»، فلما جاءه سهيل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بكتاب يكتبه يكون بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ويراد بالكتاب: معاهدة أو هدنة تكون بين المسلمين والكفار في أمرهم هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه -هو: علي بن أبي طالب- وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بـ«بسم الله الرحمن الرحيم»، فاعترض سهيل على قوله: «الرحمن»، وقال: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب بـ(اسمك اللهم) كما كنت تكتب»، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام يكتب ذلك، فاعترض الصحابة على تغيير البسملة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رغبة سهيل، وطلب من كاتبه أن يكتب «باسمك اللهم»، ثم استكمل الكتابة، وفيها: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»، فاعترض سهيل، وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله». فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب (محمد بن عبد الله)»، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله: «والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»
ثم بدؤوا في كتابة شروط الصلح، وفيها: أن تخلوا بيننا وبين البيت لنطوف به، فأقره سهيل، ولكن على أن يكون الطواف في العام المقبل؛ حتى لا تتحدث العرب أنهم أخذوا ضغطة، أي: قهرا وإجبارا، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا: وأنه لا يأتي رجل من قريش مسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رده عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترض الصحابة على هذا الشرط، وقالوا متعجبين: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟! فبينما هم كذلك يتفاوضون على هذا الشرط إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، والرسف: المشي البطيء بسبب القيود، فلما رآه سهيل، قال: إن هذا أول من يدخل في هذ الشرط، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نقض الكتاب بعد»، أي: لم ننته منه حال دخول أبي جندل علينا، فتعنت سهيل، وقال: «فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا»، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط على أن يستثني منه أبا جندل، وفاوض عليه النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا مرة أخرى: «فأجزه لي»، أي: وافق على أبي جندل بصفة خاصة، فرفض سهيل طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت هذه الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسهيل بن عمرو، فتدخل مكرز الذي كان حاضرا لكتابة الصلح، قائلا: «بل قد أجزناه لك»، أي: وافقنا على طلبك هذا، ويوضح كلام أبي جندل الآتي أنه لم ينزل سهيل على كلام مكرز، بل رده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى إن أبا جندل قال متعجبا: «أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما! ألا ترون ما قد لقيت؟!» وكان قد عذب عذابا شديدا في الله
فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من موقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروط الصلح التي ليس في ظاهرها خير للمسلمين، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم متسائلا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه: «ألست نبي الله حقا؟! قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟! قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟! قال: إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به»، والدنية: النقيصة والمذلة، فأتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما وقال له مثلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: «أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه؛ فوالله إنه على الحق»، والمراد بـ«استمسك بغرزه»: الزم أمره، وتمسك به ولا تخالفه؛ فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيد بالوحي، ومؤيد من الله عز وجل، يقول عمر رضي الله عنه بعد موقفه هذا: «فعملت لذلك أعمالا»، أي: فعلت أعمالا صالحة عسى أن يكفر الله لي بها موقفي هذا
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وانعقد الصلح الذي بينه وبين قريش، أمر الصحابة أن ينحروا ويحلقوا، فلم يستجب منهم أحد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، وفي كل مرة لم يستجب أحد من الصحابة، ولعلهم تأخروا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ رجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور؛ ليتم لهم قضاء نسكهم
فدخل صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة يشكو إليها امتناع أصحابه رضوان الله عليهم من تلبية أوامره، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتكلم مع أحد منهم كلمة حتى ينحر بدنه، ويدعو حالقه فيحلقه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت، فخرج وفعل ما أشارت به، فلما رأى الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ففعلوا فعله واهتدوا بهديه، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، أي: حزنا على أنهم صدوا عن البيت ولم يكملوا نسكهم، ولتحققهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الأمر نافذ، وأن الوحي لم ينزل ولم يبطل الله الصلح وشروطه المجحفة، وأنهم بذلك قد تأخروا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول لهم بالتحلل والحلق والنحر
ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسوة مؤمنات بعد كتابة الصلح، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]، والمراد: أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل النساء التي أتت إليه بعد اختبارهن بعد أن عرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام، وبعد التأكد لا يعيد المسلمون النساء المؤمنات إلى الكفار، وعلى المؤمنين ألا يستمسكوا بزوجاتهم الكافرات، فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا زوجتين له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير -وهو رجل من قريش- إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهم وبينه في رد كل من يأتي مسلما من قريش، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لهم، فخرج الرجلان اللذين أرسلتهما قريش بأبي بصير من المدينة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فاستغل أبو بصير رضي الله عنه الموقف وخادع الرجلين اللذين كانا معه، فقال لأحدهما: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله صاحب السيف له، أي: سحبه من جرابه، وبدأ الرجل يمدح في سيفه له، فطلب أبو بصير أن يريه سيفه ويضعه في يده، فأعطاه الرجل له، فضربه أبو بصير بالسيف حتى برد، أي: مات، فلما رأى ذلك الرجل الآخر فر هاربا نحو المدينة حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعدو، أي: يسرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرا»، أي: فزعا وخوفا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: يا نبي الله، قد -والله- أوفى الله ذمتك؛ قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، فليس عليك حرج بعدما وفيت لهم عهدهم، وقال أبو بصير ذلك ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرضى به ويبقي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل أمه! مسعر حرب، لو كان له أحد»، والويل: العذاب، وهي كلمة أصلها دعاء على الشخص، ولكنها استعملت هنا للتعجب من عمله، و«مسعر حرب»: محرك للحرب وموقد لنارها، والمراد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجب من فعلة أبي بصير، حتى وصفه بأنه محرك للحرب وموقدها لو كان معه أحد ينصره ويعاضده، فعرف أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرده إلى قريش بعد كلمته هذه، فخرج حتى أتى سيف البحر، و«سيف البحر» بكسر السين، وهو على ساحل البحر، وكان في طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام، فانفلت إليه أبو جندل بن سهيل؛ أي تخلص من قريش بالذهاب إلى أبي بصير، كما لحق به كل رجل أسلم من قريش بعد الصلح، حتى اجتمعت منهم عصابة -جماعة تقدر الأربعين فما فوق ذلك- فما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، والمراد بالعير: القافلة، فتضررت قريش من هذا، حتى إنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تناشده بالله والرحم الذي بينهم أن يرسل إلى أبي بصير ومن معه ليكفوا عنهم ما يفعلون، وأن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آمن، وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم، فأنزل الله عز وجل على إثر هذا الحدث قوله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا * هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما * إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية} [الفتح: 24-26]، والحمية: هي التعصب لغير الحق، وكانت حمية قريش أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بـ«بسم الله الرحمن الرحيم»، وحالوا بينهم وبين البيت
وفي الحديث: أن الله تعالى ينصر هذا الدين بما قد يظن البعض أنه خذلان، وأن الفرج مع الصبر
وفيه: أن طاعة الله ورسوله واجبة دون النظر إلى معرفة الحكمة من الأمر أو النهي
وفيه: أن بعض الأمور قد تخفى على ذوي العقول والبصيرة
وفيه: أن الدين مبني على التسليم لأمر الله سبحانه والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم

 DOAA M
DOAA M