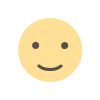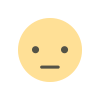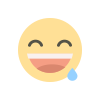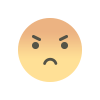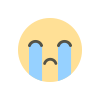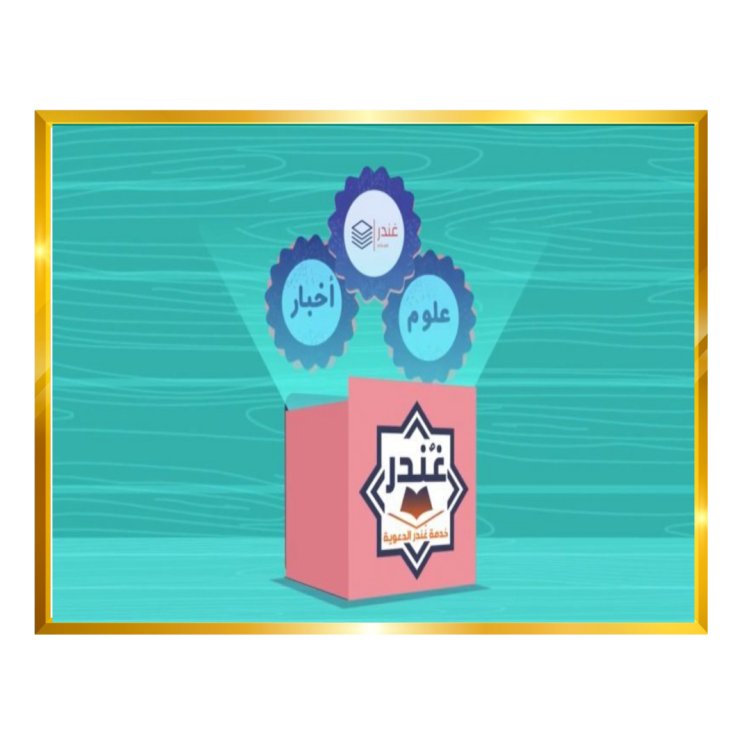باب فى القدر

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال « نعم ». قال ففيم يعمل العاملون قال « كل ميسر لما خلق له ».

في هذا الحديث يحكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو ما عظم من شجر العوسج، كان ينبت فيه، فذهب الشجر وبقي الاسم لازما للمكان، وهي مقبرة المدينة، إلى جوار المسجد النبوي الشريف، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد وقعدوا حوله، ومعه «مخصرة»، أي: وهي عصا يتوكأ عليها، فخفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم المفكر، كما هي عادة من يتفكر في شيء حتى يستحضر معانيه، فيحتمل أن يكون ذلك تفكرا منه صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة؛ لقرينة حضور الجنازة، أو فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه، فجعل يضرب في الأرض بالعصا، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ما منهم من أحد وما من نفس مولودة ومخلوقة، إلا كتب مكانها -يعني: قدر وعين- الذي تصير إليه من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية، أي: معذبة بالنار، أو سعيدة وفرحة بالجنة
فسأل رجل -قيل: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل غيره-: «يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟» يعني: أفلا نعتمد على ما قدر علينا، ونترك العمل؛ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير -أي: سيجره القضاء- إلى عمل أهل السعادة، أي: قهرا ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة -يعني: قهرا-؟ وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل، ما دام أننا سنصير إلى ما قدر علينا، وأن السعي لا يرد قضاء الله وقدره؟ وحاصل الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا مشقة؛ لأن كل أحد ميسر لما خلق له، وهو يسير على من يسره الله عليه. فمنعهم عن الاتكال، وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، مع عدم جعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم -تصديقا لإجابته- قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى} [الليل: 5 - 10]
وفي الحديث: مشروعية الموعظة عند القبر
وفيه: الجمع بين الإيمان بالقدر، والأخذ بالأسباب في العمل

 DOAA M
DOAA M