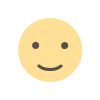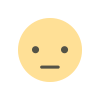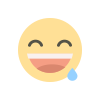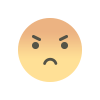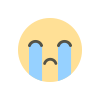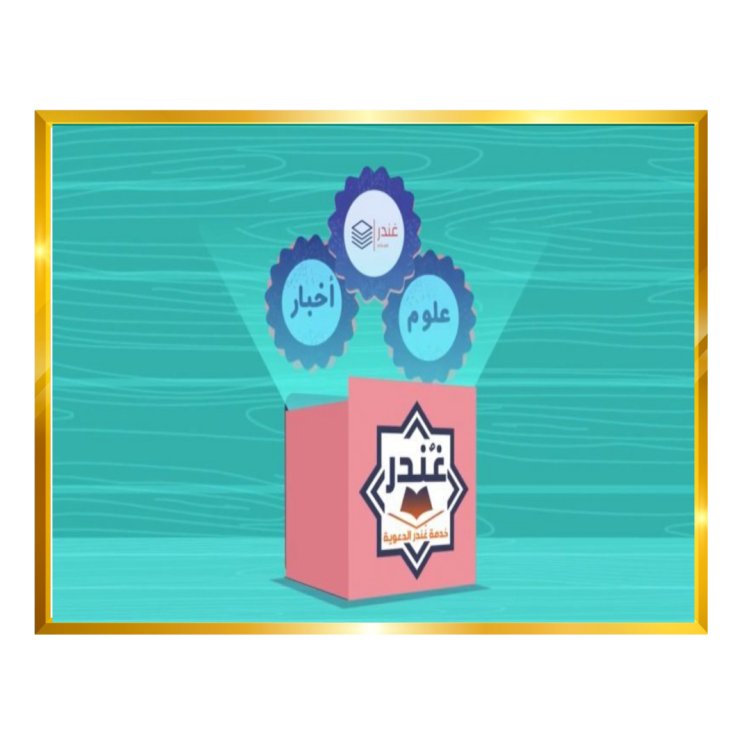مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 779
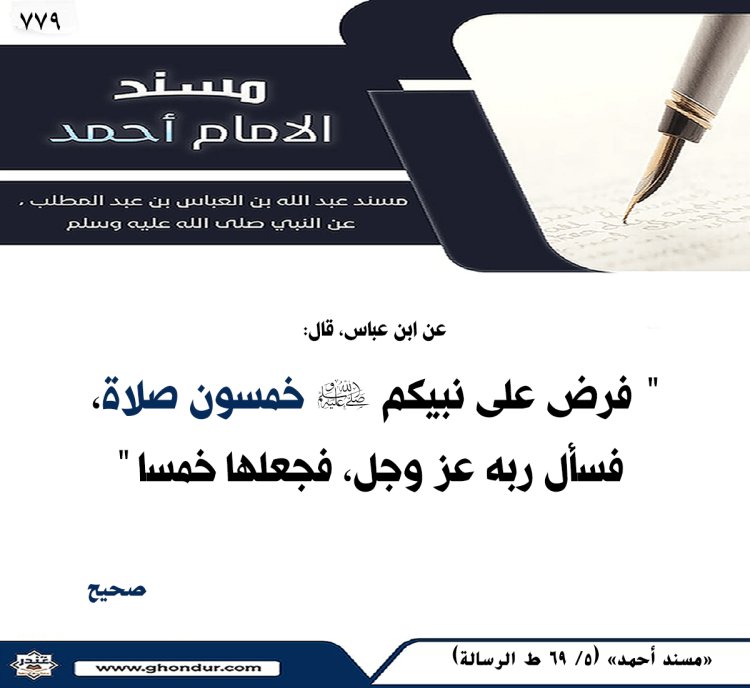
حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن أبي علوان، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " فرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم خمسون صلاة، فسأل ربه عز وجل، فجعلها خمسا " (2)

كانت رحلة الإسراء والمعراج من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة جرت فيما بين السنة الحادية عشرة والسنة الثانية عشرة من البعثة، بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة بنت خويلد وعمه أبا طالب اللذين كانا يؤانسانه ويؤازرانه، وبعد ما لاقاه من أذى أهل الطائف، فضاقت الأرض به؛ فواساه الله سبحانه وتعالى بهذه الرحلة المباركة تثبيتا له حتى أراه الجنة، وأراه إخوانه من الأنبياء، وأراه من آياته الكبرى
وفي هذا الحديث يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام عند الكعبة إلى بيت المقدس: أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من الملائكة، قبل أن يوحى إليه ويكلفه الله عز وجل بالبلاغ، وهو نائم في المسجد الحرام، وكان صلى الله عليه وسلم نائما بين اثنين -قيل: إنه كان نائما معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه، وجعفر بن أبي طالب ابن عمه- فلما أتته الملائكة ووقفت عنده، فقال أولهم: «أيهم هو؟» أي: أي الثلاثة النائمين يكون محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أوسط الملائكة: «هو خيرهم»، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان نائما بين الاثنين، وقال آخرهم -والمراد به الملك الثالث-: خذوا خيرهم للعروج به إلى السماء، ولم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام، ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاؤوا إليه ليلة أخرى بعد أن أوحي إليه، والمراد بها ليلة الإسراء، فرأى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا كناية عن حضورهم لما يشاهدونه، فرؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي من الله عز وجل
فحملت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وجاؤوا به إلى بئر زمزم، فتولاه جبريل عليه السلام -وهو الملك الموكل بالوحي- فقام بشأنه، وتولى إجراء ما جرى له؛ فشق جبريل عليه السلام صدره ما بين عنقه إلى «لبته» وهو موضع القلادة من الصدر إلى أسفل صدره، فغسله بماء زمزم حتى نقى صدره وجوفه، ثم أتى بطست من ذهب، وهو وعاء واسع مملوء إيمانا وحكمة، وفيه تور من ذهب -وهو إناء صغير يغرف به-، فأخذ ما في هذا الوعاء الكبير وحشا به قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولغاديده -يعني: عروق حلقه- إيمانا وحكمة، ثم أطبقه، وفي رواية مسلم: «فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه»، ومعناه: جمعه وضم بعضه إلى بعض، وهذا من إعداده للرحلة المباركة، وفي حديث مالك بن صعصعة الذي أخرجه مسلم: «ثم أتيت بدابة أبيض، يقال له: البراق، فوق الحمار، ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه»، ثم «عرج» أي: صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا، وهي السماء الأولى -وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل معراجه إلى السماء كان قد أسري به إلى بيت المقدس، فصلى به ركعتين- فضرب بابا من أبواب السماء، أي: قرعه ودق عليه، فسألت ملائكة السماء: من هذا؟ أي: من المستفتح؟ قال جبريل عليه السلام: «جبريل»، وهذا بيان لأدب الاستئذان بين الملائكة، وسألوه عمن معه، فأخبرهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقد بعث؟ وفي البخاري عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه: «وقد أرسل إليه؟»، أي: هل أرسل الله بأمر عروجه إلى السماء؟ وليس المقصود السؤال عن الإرسال إلى النبي بالرسالة والنبوة، قيل: الحكمة في قولهم هذا أن الله أراد إطلاع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه معروف عند الملأ الأعلى؛ لأنهم قالوا: أرسل إليه، فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع، وإلا لكانوا يقولون: من محمد؟
فرحبت الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستبشرون به صلى الله عليه وسلم، وقوله: «لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم» يدل على أن أهل السموات وإن كانوا مقربين من الله سبحانه، إلا أنهم لا يعلمون ماذا يريد الله بأي أمر ينزل من السماء أو يرفع من الأرض حتى يعلمهم الله سبحانه به وبحكمته منه
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى أبا البشر آدم عليه السلام، فقال له جبريل: «هذا أبوك آدم فسلم عليه»، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه آدم عليه السلام، ورحب به، وقال: «نعم الابن أنت»، وفي رواية مالك بن صعصعة: «مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» وذكره بالبنوة؛ لافتخاره بأبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالصالح؛ لأن الصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد، فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني الخير
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهرين «يطردان» أي: يجريان، فسأل عنهما جبريل عليه السلام، فأخبره أنهما النيل والفرات، وقوله: «عنصرهما» أي: إن هذا أصل منبعهما، وقيل: أراد موضع اجتيازهما. وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى، ويجمع بين الحديثين بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى، ومقرهما في السماء الدنيا، ومنها ينزلان إلى الأرض ونهر النيل في الأرض: ينبع ويسيل من رافدين: النيل الأبيض، وهو أقصى روافده، يأتي من جنوب القارة الإفريقية عند هضبة البحيرات (بحيرة فكتوريا)، والنيل الأزرق، وينبع من هضبة الحبشة (بحيرة تانا بإثيوبيا)، يأتيان من الجنوب مرورا على طول البلاد إلى أن يجتمعا بأرض السودان، ثم أرض مصر، فيفيضا في البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله: 6.853 كم، ونهر الفرات: ينبع من تركيا، ويسير في أراضيها، ويتابع طريقه في الأراضي السورية، ومن ثم في الأراضي العراقية، وينتهي به المطاف إلى الخليج العربي بعد أن يتحد مع نهر دجلة، ويبلغ طوله: 2.781 كم
ثم مضى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، فرأى نهر الكوثر الذي أعطاه الله له، وهو من المسك الأذفر، أي: ذي الرائحة الذكية، وفوقه قصر من لؤلؤ وزبرجد، وهو نوع من أنواع الجواهر، وقد ادخره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأشهر -كما عند البخاري- أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى الكوثر بينما هو يسير في الجنة، فيحتمل أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف، تقديره: ثم مضى به في السماء الدنيا إلى السابعة، فإذا هو بنهر؛ لأن بالسماء السابعة الجنة.
ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم باقي السموات السبع، وقد وقع من ملائكة كل سماء منها مثل ما وقع من ملائكة السماء الأولى، وفي كل سماء وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنبياء، ففي الثانية وجد إدريس عليه السلام، وفي الرابعة هارون عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء الخامسة ورأى فيها آخر لم يحفظ اسمه، وفي السادسة رأى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وفي السابعة رأى موسى عليه السلام؛ وهذا الفضل بسبب كلام الله إياه. ولم يكن موسى يعتقد أن يرفع الله عليه أحدا؛ حيث علا جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى وهي: شجرة عظيمة جدا، وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله؛ من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها من الملائكة والإنس؛ لكونها فوق السموات والأرض، فهي المنتهى في علوها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودنا الجبار رب العزة فتدلى -وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه- حتى كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين، وهو الآلة التي ترمي السهام، أو أقرب، وفي الصحيحين أن زر بن حبيش سأل ابن مسعود عن معنى قول الله تعالى: {فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى} [النجم: 9، 10]، فأجاب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح، وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: «رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض»
فأوحى الله إلى نبيه وهو في هذا المقام أن فرض على أمته خمسين صلاة، كل يوم وليلة، ثم بعد ذلك هبط صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وهنا تكلم معه موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه ويطلب منه التخفيف في عدد الصلوات، فخففها الرحمن من خمسين إلى أربعين، ولم يزل يردده موسى إلى ربه تعالى حتى صارت خمسا، ولما هبط قال له موسى: والله، لقد راجعت بني إسرائيل قومي على أقل من هذا القدر من هذه الصلوات الخمس فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع إلى ربك فليخفف عنك، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جبريل؛ ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه إلى ربه، فطلب منه التخفيف، فقال الجبار: يا محمد، فأجابه: «لبيك رب»، أي: أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة، «وسعديك»، أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، وأكرر ذلك مرة بعد أخرى
فقال له الله سبحانه: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك -أي: وعلى أمتك- في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك وعلى أمتك، أي: إن كل صلاة من الخمس بعشر درجات، فتعدل الصلوات الخمس خمسين صلاة في الأجر، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام، فسأله: كيف فعلت؟ فقال: خفف ربنا عنا؛ أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راجعت بني إسرائيل على أقل من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي بسبب ما اختلفت إليه ورجعت إليه كثيرا لطلب التخفيف؛ فلم يرجع. ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة إنما جازت من رسولنا محمد وموسى عليهما السلام؛ لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعا، فلو كان واجبا قطعا لما قبل التخفيف
فقال له جبريل: فاهبط باسم الله. وأنزله إلى الأرض
وقوله: «واستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الحرام»، أي: واستيقظ من نومة نامها بعد الإسراء والمعراج؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلته، وإنما كان في بعضها، وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم»، فمراده في أول القصة؛ وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه، فأتاه الملك فأيقظه، وفي قوله في رواية مالك بن صعصعة التي في الصحيحين: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه.
وهذه الرواية رواية شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك، قد خالفت غيره من المشهورين في عدة أشياء:
1- أمكنة الأنبياء في السموات، وقد أفصح هو بأنه لم يضبط منازلهم
2- وكونه قبل البعثة، وقد قدمنا أن معراجه كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك؛ كيف يوحى إليه بالصلاة، ولم يوح إليه بالرسالة؟!
3- أن الإسراء والمعراج وقع له في المنام، والثابت أنه صلى الله عليه وسلم حضر تلك الرحلة بجسده الشريف
4- وقوله في سدرة المنتهى: إنها فوق السماء بما لا يعلمه إلا الله تعالى، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة
5- وقوله في النيل والفرات إن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور أنه في السابعة
6- وأن الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور أنه في الجنة
7- ونسبة الدنو والتدلي في قوله: «ثم دنى فتدلى» إلى الله تعالى، والمشهور أنه لجبريل
وفي الحديث: ثبوت رحلة المعراج
وفيه: عظيم رحمة الله عز وجل بنبيه وأمته
وفيه: أدب النبي صلى الله عليه وسلم في استشارته لجبريل عليه السلام قبل مراجعته لربه عز وجل
وفيه: تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام
وفيه: ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى
وفيه: ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى