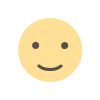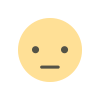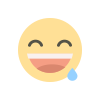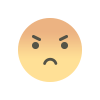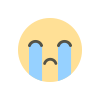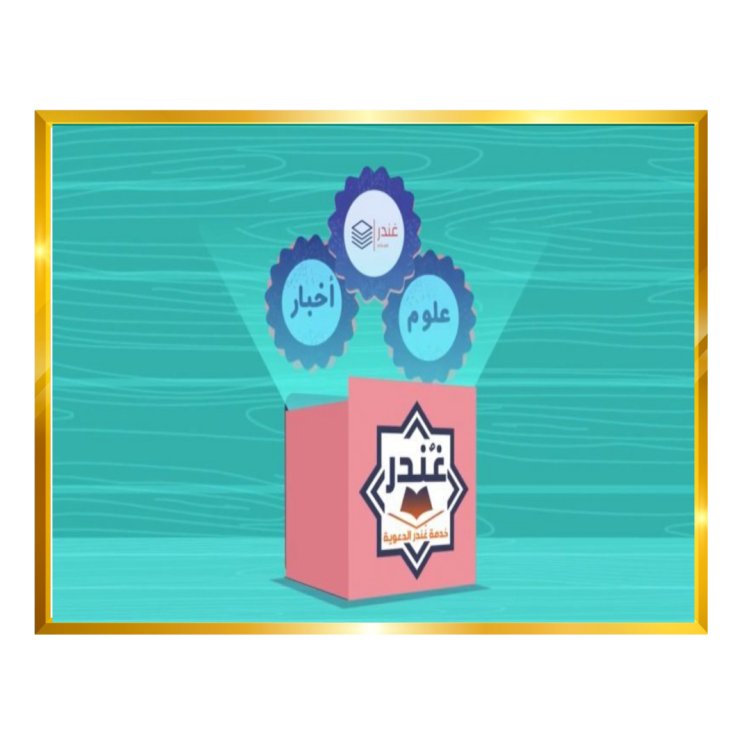باب الرجاء 27
بطاقات دعوية



وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة - بفتح العين والباء - السلمي - رضي الله عنه - قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخفيا، جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليهبمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي» قلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء»، قلت: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد»، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال - رضي الله عنهما، قلت: إني متبعك، قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني». قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم، أنت الذي لقيتني بمكة» قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة (1) محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر (2) جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه؟ فقال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه».
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول! في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن«رياض الصالحين ت الفحل» (ص156):
أكذب على الله تعالى، ولا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا - حتى عد سبع مرات - ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. (1)
قوله: «جرآء عليه قومه» هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي: جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة، ورواه الحميدي (2) وغيره «حراء» بكسر الحاء المهملة، وقال: معناه غضاب ذوو غم وهم، قد عيل صبرهم به، حتى أثر في أجسامهم، من قولهم: حرى جسمه يحرى، إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم.
قوله - صلى الله عليه وسلم: «بين قرني شيطان» أي ناحيتي رأسه والمراد التمثيل، ومعناه: أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته، ويتسلطون.
وقوله: «يقرب وضوءه» معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به، وقوله: «إلا خرت خطايا» هو بالخاء المعجمة: أي سقطت، ورواه بعضهم «جرت» بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله: «فينتثر» أي يستخرج ما في أنفه من أذى والنثرة: طرف الأنف

ظهر الإسلام في عالم قد ملئ بالظلم والشرك والجهل؛ فكانت إشراقات تعاليمه غريبة بين أناس عاشوا في الظلام الدامس، وتعرض أتباعه الأوائل لمحن شديدة؛ فقد كان عددهم قليلا جدا، يراهم أعداؤهم ضعفاء أذلاء، ويقهرونهم ويؤذونهم؛ إذ لم تكن لديهم منعة بكثرة ولا بقوة، وذلك قبل أن يمن الله تعالى عليهم بالهجرة إلى المدينة النبوية، التي آواهم فيها وقواهم، وأعانهم ونصرهم على أعدائهم
وفي هذا الحديث يخبر الصحابي عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه -وكان أخا لأبي ذر من أمه، أمهما رملة، من بني الوقيعة بن حرام بن غفار، وهو من بني سليم- أنه كان في الجاهلية -وهي المدة التي كان الناس فيها على الشرك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بها لكثرة جهالاتهم- يظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء من الحق والدين ينفعهم عند الله تعالى «وهم يعبدون الأوثان»، جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله، سواء أكان من حجر أو خشب، أو شجر، وسواء أكان على صورة آدمي أم لا، ثم بعد ذلك سمع بظهور رجل -يقصد النبي صلى الله عليه وسلم- بمكة يخبر عن الله عز وجل أخبارا، أي: أخبار النبوة والرسالة ووحي الله إليه، وأمره بالتوحيد وببطلان الشرك مع الله تعالى، فركب على دابته، وسافر إلى مكة ليعلم من خبر هذا النبي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستترا من الكفار؛ لأنهم كانوا »جرآء» جمع جريء، من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط والإيذاء له، فترفق وتلطف في البحث عنه والوصول إليه في مكة؛ حتى لا يصده عنه كفار قريش، حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنت؟»، أي: ما حالك وشأنك، ولم يقل: من أنت؛ لأنه لم يسأله عن ذاته، وإنما سأله عن صفاته، فأجابه صلى الله عليه وسلم: «أنا نبي» من أنبياء الله تعالى؛ وذلك بما أوحى الله سبحانه إلي، فسأله عن حقيقة النبي المميزة له عن سواه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله الله إلى كافة الخلق، فسأله: «وبأي شيء أرسلك؟» فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله بصلة الأرحام، وهم أقارب الإنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا لهم أو غير وارث، وتتأكد الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا. وجوابه صلى الله عليه وسلم هنا كان بحسب السائل، وبحسب الزمان والحال، فتخصيص الرحم بالذكر يحتمل لمراعاة حال العرب فيها، أو أن غيرها من الفرائض لم يكن فرضا
وأخبره أن الله عز وجل أرسله بكسر الأوثان وهدمها، ويشمل النهي عن التعبد إليها، وبأن يوحد الله ويفرده بالعبادة، فلا يشرك به شيئا من المخلوقات، فسأل عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن معك على هذا» التوحيد والدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »حر وعبد»، وأخبر عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يومئذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقصد به الحر، وبلال بن رباح رضي الله عنه، ويقصد به العبد، ممن آمن به صلى الله عليه وسلم وصدق برسالته، واتبعه على ملته.
فقال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني متبعك» على هذا الدين، وهو كناية عن دخوله في الإسلام، ومن ثم أصحبك وأكون معك في موضعك هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا»، أي: في هذا الزمن الحاضر؛ وذلك لضعف شوكة الإسلام، فيخاف عليك من أذى كفار قريش، فلم يرد عليه إسلامه، وإنما رد عليه كونه معه، وعلل ذلك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الأعوان، وحال الكفار من قوة شوكتهم، وشدة عداوتهم، وأمره أن يرجع إلى قومه، وأن يكون فيهم، وأن يبقى على إسلامه، فإذا سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وغلبته وعلوه على المشركين، وانتشرت الدعوة في الأرض، فليأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب؛ فهو داخل في باب دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم
فرجع عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى أهله بني سليم، ثم بعد مدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا بعد أن مكث في مكة نبيا مرسلا ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى التوحيد، ونبذ الشرك، وكان عمرو رضي الله عنه في أهله مقيما فيهم، فجعل يتطلب الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ويسأل من يمر به من المسافرين حتى جاء نفر من أهل يثرب، والنفر: ما بين الثلاثة والتسعة من الرجال، ويثرب هو الاسم القديم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها، وسماها طيبة وطابة. فسألهم: «ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟» وإنما أخرج السؤال هذا المخرج؛ تعمية لحاله على المسؤولين؛ خشية أن يكونوا من أعدائه صلى الله عليه وسلم، فلا يخبرونه بحقيقة الأمر إذا علموا أنه على دينه، وهذا من فقه عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقوة فطنته وذكائه، فأجابوه: الناس إليه مسرعون في اتباعه على دينه، والدخول في الإسلام، «وقد أراد قومه»، أي: كفار قريش «قتله» بأنواع من المكر والخديعة «فلم يستطيعوا ذلك» بل رد الله كيدهم في نحرهم، وحفظ نبيه من ذلك، قيل: أريد بذلك ما دبرت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من غزوة بدر وأحد والأحزاب، وغيرها، فلم يستطيعوا القضاء عليه، بل نصره الله تعالى عليهم. ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره الله تعالى في قوله: {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} [الأنفال: 30]، وذلك حين ائتمروا عليه بهذه الأمور، فأذن الله له في الهجرة، فأنزل الله تعالى عليه بعد قدومه المدينة »سورة الأنفال» يذكر نعمه عليه، وبلاءه عنده.
ثم أخبر عمرو رضي الله عنه أنه جاء المدينة -وكان قدومه إلى المدينة بعد مضي بدر وأحد والخندق وخيبر- ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، أتعرفني؟» فأجابه: نعم، أنت الذي قابلتني في مكة، فطلب عمرو رضي الله عنه أن يخبره عما علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ويجهله عمرو رضي الله عنه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن الصلاة وعن وقتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصبح -ووقته بظهور الفجر الصادق- ثم يمتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع بالقدر الذي يزول معه كراهة الصلاة، وهو في التقدير المعاصر ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وهذا بيان لأول أوقات النهي عن الصلاة، وبين له علة هذا النهي بأن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار الذين يعبدونها، والمعنى: أن الشيطان زين لبعض الناس عبادة الشمس في هذا الوقت، وكان يقارن طلوع الشمس ويقترب منها، ويجعلها بين قرنيه اللذين في رأسه، فتشرق بينهما، وكذلك وقت الغروب، فكأن الذين يسجدون للشمس يسجدون له، فيكون ذلك من البعد عن مشابهة المشركين في وقت صلاتهم. وهذا النهي يختص بصلاة النوافل التي لا سبب لها؛ فلا ينبغي للمسلم أن يصليها في هذين الوقتين، أما صلاة الفوائت من الفرائض فإنها تؤدى في جميع أوقات النهي.
ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ذلك الوقت يصلي ما شاء من النوافل، كما في رواية أبي داود، «فإن الصلاة مشهودة محضورة»، أي: يحضرها الملائكة؛ ليكتبوا أجرها، ويشهدوا بها لمن صلاها، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، فيصلي «حتى يستقل الظل بالرمح»، أي: حتى يرتفع الظل مع الرمح، أو في الرمح، ولم يبق على الأرض منه شيء. والرمح هو الرمح الحربي العربي، ويبلغ طوله تسعة أشبار متوسطة، وتخصيص الرمح بالذكر؛ لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض، ثم نظروا إلى ظلها.
فإذا لم يكن للشيء ظل، فليتوقف عن الصلاة النافلة التي لا سبب لها، فإن هذا الوقت وقت «تسجر جهنم» فيه، أي: يوقد عليها إيقادا بليغا، «فإذا أقبل الفيء» إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، «فصل» أي صلاة تريدها؛ «فإن الصلاة مشهودة محضورة» واستمر في الصلاة ما شئت «حتى تصلي العصر»، ثم انته عن الصلاة النافلة بعد العصر، حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، كما تقدم.
ثم سأل عمرو بن عبسة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء وكيفيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم رجل يقرب وضوءه»، أي: يحضر ما يتوضأ به من الماء، «فيتمضمض» والمضمضة: إدارة الماء في الفم ثم مجه وإخراجه منها، «ويستنشق» ويكون بإدخال الماء في الأنف، »فينتثر»، أي: يدفعه ليزيل ما في أنفه من الأذى، «إلا خرت»، أي: سقطت خطايا وجهه وفمه وخياشيمه، «ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله»، أي: بقوله عز وجل: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]، «إلا سقطت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء»، عبر باللحية للغالب، وإلا فمن لا لحية له -كالأمرد والمرأة- كذلك، «ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهما المفصلان اللذان في منتصف الذراعين، إلا سقطت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا سقطت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، وذكر الشعر للغالب على الناس، فيشاركه في الحكم من لا شعر له، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين -وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم- إلا سقطت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن قام المتوضئ بهذه الصفة، فدخل في الصلاة، فحمد الله، وأثنى عليه بالصفات الثبوتية، وأثنى عليه بالتنزيه عما لا يليق به، ومجده، فوصفه بالذي هو له أهل من أوصاف المجد، وهو العز والشرف، «وفرغ قلبه لله» تعالى، أي: فرغه من دنس التعلق بغير الله والركون إلى سواه، «إلا انصرف خارجا من خطيئته» وذنوبه، فيصير متطهرا منها كطهارته من كل خطيئة، «يوم ولدته أمه».
فحدث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: «يا عمرو بن عبسة، انظر»، أي: تفكر وتأمل «ما تقول»، وفيما تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل في مقام ومكان واحد، يعطى الرجل هذا الثواب العظيم! ولفظ النسائي: »أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟!» وليس هذا اتهاما من أبي أمامة لعمرو رضي الله عنهما، وإنما هو تعجب من عظيم فضل الله تعالى، فقال عمرو: «يا أبا أمامة، لقد كبرت سني» وعمري، »ورق عظمي»، أي: نحف ونحل، وهذا كناية عن ضعفه، «واقترب أجلي» من الموت، «وما بي حاجة» ولا داعية «أن أكذب على الله» تعالى «ولا على رسول الله» صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أن الأسباب الحاملة على الكذب عادة منتفية عني، فلست كاذبا، فـ«لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد سبع مرات»، أي: بأن قال: أو أربعا، إلى أن قال: أو سبع مرات، «ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك»، وفي رواية النسائي: «ولقد سمعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني: أنه متثبت في نقل هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن قلبه وعاه له، ولم يطرأ عليه نسيان، وهذا كله من التوثق من صحة الرواية.
وفي الحديث: الحث على صلة الأرحام؛ لأن الله تعالى قرنها بالتوحيد
وفيه: التطوع بالصلاة في كل وقت، إلا أوقات النهي.
وفيه: بيان وقت صلاة الصبح.
وفيه: بيان أوقات النهي عن الصلاة غير المكتوبة.
وفيه: فضل إسباغ الوضوء.
وفيه: فضل الخشوع في الصلاة.
وفيه: النهي عن مشابهة الكفار في عبادتهم.
وفيه: بيان فضل أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، حيث كانا سابقين إلى الإسلام.
وفيه: بيان فضل عمرو بن عبسة رضي الله عنه وكمال عقله، حيث كان يدرك في الجاهلية أن الناس في ضلال، حيث يعبدون الأوثان من دون الله تعالى، وسبق إلى الإسلام.
وفيه: بيان أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن أفضل الأوقات والأماكن ليتقرب فيها إلى ربه، ويكثر من طاعته.
وفيه: الاستثبات في الأخبار، وإن كان المخبر صادقا؛ إذ ربما يطرأ له نسيان، أو نحوه.

 Khurshid
Khurshid