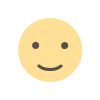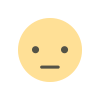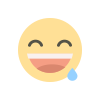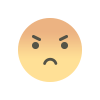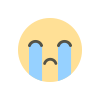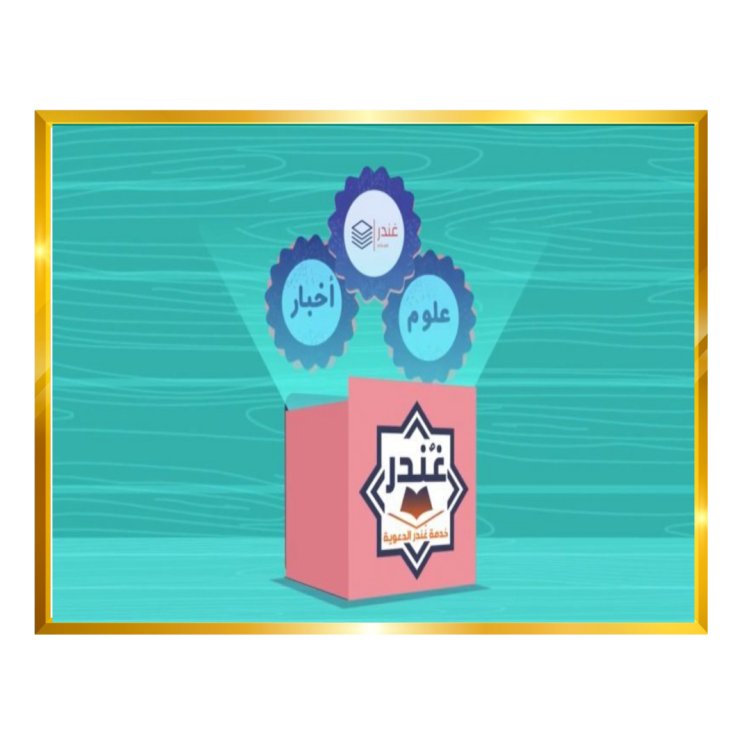باب فى الرؤية
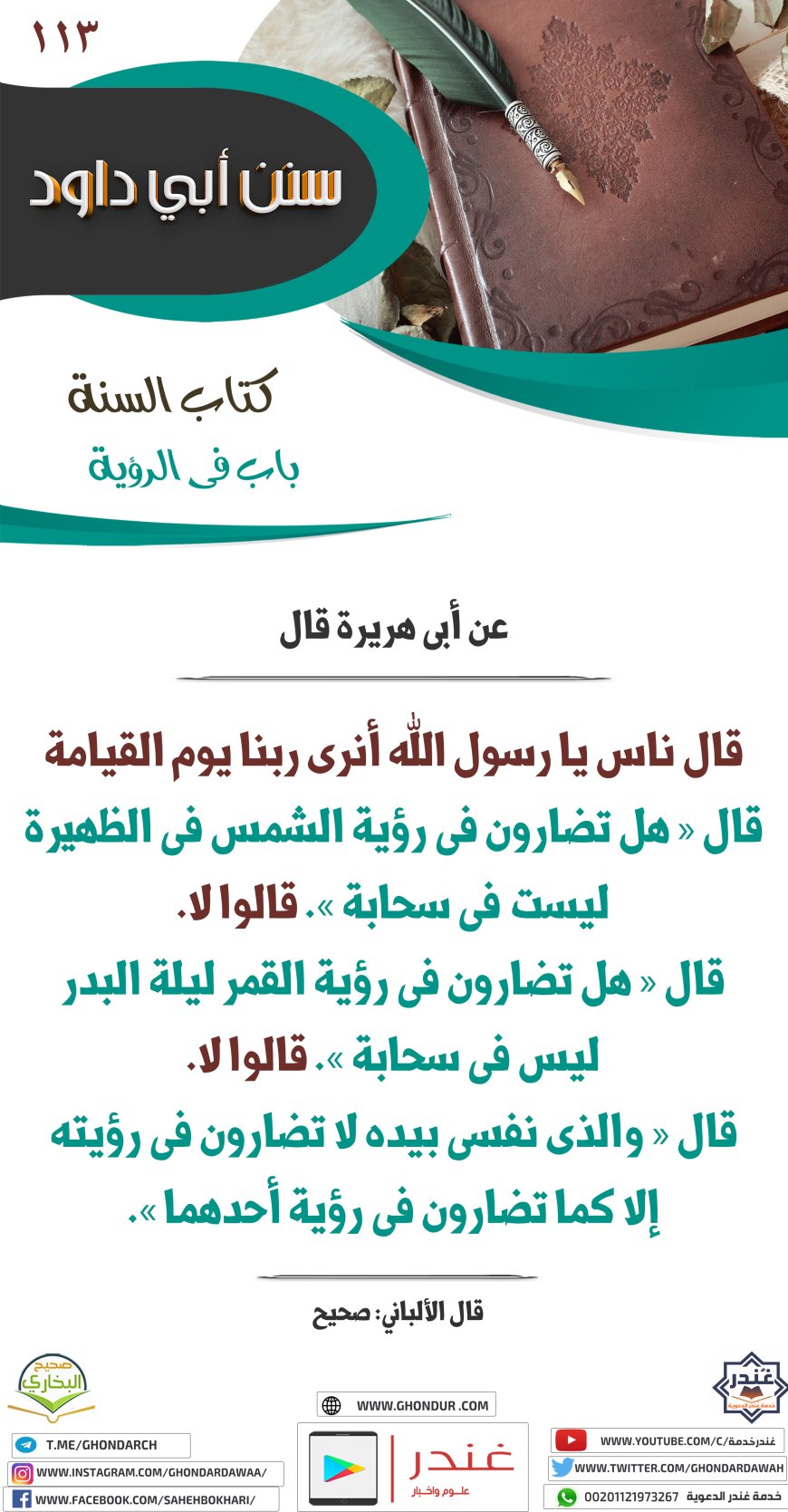
حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبى هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال « هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة ». قالوا لا. قال « هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة ». قالوا لا. قال « والذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤيته إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما ».

قضى الله عز وجل ألا يراه خلقه في الحياة الدنيا، وسينعم على عباده الصادقين برؤيته سبحانه في الآخرة، وهذا من أكمل النعم التي ينالها المؤمن في الآخرة
وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم: «نعم»، وأكد لهم صلى الله عليه وسلم الجواب بتصوير يظهر فيه مدى تحقق وتباين تلك الرؤية، فسألهم: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» أي: هل يحدث لكم ضرر أثناء رؤيتكم للشمس في وضح النهار؛ من نحو منازعة، أو مجادلة، أو مضايقة، أو مزاحمة من أحد؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا. وأكد لهم الأمر بسؤال آخر حول رؤيتهم للقمر؛ قال صلى الله عليه وسلم: «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا. والمعنى: أنكم سترون الله عز وجل في وضوح تام ودون مزاحمة لا تضرون أحدا، ولا يضركم أحد بمنازعة أو نحوها، كما ترون الشمس في وضح النهار مضيئة في وقت الظهيرة، ليس بينكم وبينها سحاب، وكما ترون القمر بالليل ليلة اكتماله بدرا مضيئا في وضوح تام.
والتشبيه الواقع هنا إنما هو في الوضوح وزوال الشك لا في المقابلة والجهة وسائر الأمور العادية عند رؤية المحدثات؛ فالرؤية له تعالى حقيقة، لكنا لا نكيفها، بل نكل كنه معرفتها إلى علمه تعالى. قيل: هذه رؤية الامتحان المميزة بين من عبد الله وبين من عبد غيره، لا رؤية الكرامة التي هي ثواب أوليائه في الجنة
وذكر صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله عز وجل: أن تلحق كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيتبع كل من كان يعبد شيئا من دون الله ما كان يعبده، فيتساقطون جميعا في النار، فلا يبقى أحد ممن كان يعبد الأصنام -جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله- والأنصاب -جمع نصب، وهو حجر كان ينصب ويذبح عليه، فيحمر بالدم ويعبد-. كل هؤلاء يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان عابدا لله عز وجل -سواء أكان مطيعا لله، أو فاجرا منهمكا في المعاصي-، وكذا بقايا من أهل الكتاب –وهم اليهود والنصارى-، فيدعى اليهود ويسألون، فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ فيجيبون: كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، فحاشاه سبحانه أن يكون له زوجة أو ولد، فالتكذيب هنا لنفي أن يكون لله سبحانه ولد، ويلزم منه نفي عبادة غيره سبحانه، ثم يسألون: ماذا تطلبون؟ «فقالوا: عطشنا ربنا، فاسقنا، فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب»، وهو الذي يرى نصف النهار في الأرض القفر، والقاع المستوي في الحر الشديد، لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والنار حال كونها يكسر بعضها بعضا؛ لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها، فيتساقطون في النار
ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من زوجة ولا ولد، ثم يسألون فيقال لهم: ماذا تطلبون؟ فيقولون كما قالت اليهود: عطشنا ربنا، فاسقنا، إلى آخر ما قاله اليهود، ويفعل بهم كما فعل باليهود، حتى يتساقطون جميعا في النار
وذكر صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يدخل كل من يعبد غير الله النار، ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر طائع لله حال حياته في الدنيا، أو فاجر -وهو العاصي المنهمك في المعصية- جاءهم رب العالمين، وأشهدهم رؤيته سبحانه، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل «في أقرب صفة من التي» عرفوه فيها سبحانه وتعالى، فيقال: «ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: فارقنا الناس» الذين زاغوا في الدنيا عن الطاعة في الدنيا وابتعدنا عن متابعتهم «على أفقر» أي: أحوج «ما كنا إليهم» في معايشنا ومصالح دنيانا، «ولم نصاحبهم» بل قاطعناهم، «ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد في الدنيا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا»، وإنما قالوا ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى تجلى لهم بصفة لم يعرفوه. قيل: إنما حجبهم عن تحقيق الرؤية في هذه المرة من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية، وهم عن ربهم محجوبون، فإذا تميزوا عنهم رفعت الحجب، فيقولون عندما يرونه: أنت ربنا
وفي الحديث: رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة كما يشاء سبحانه

 DOAA M
DOAA M