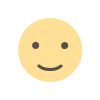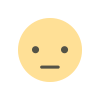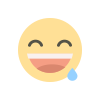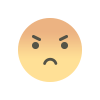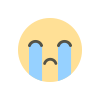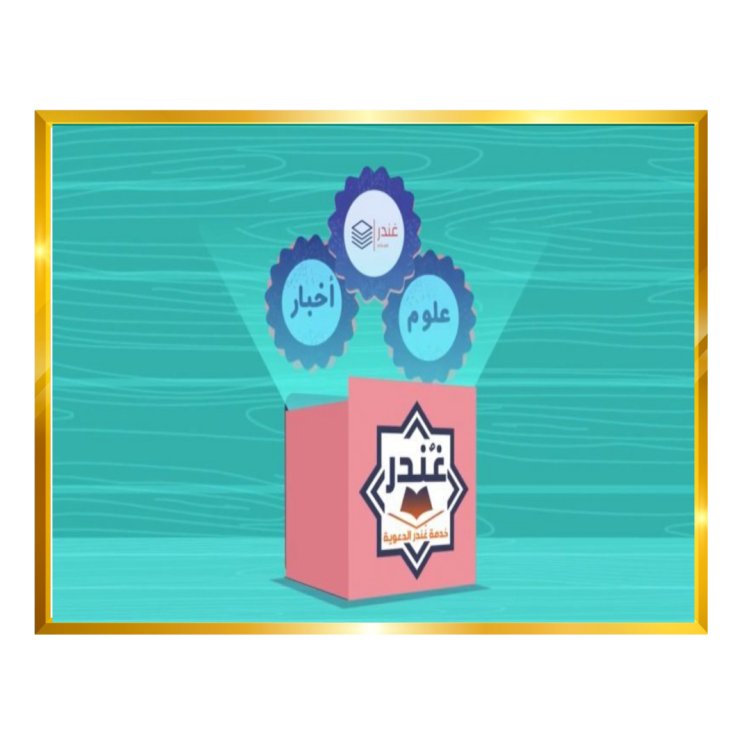باب ما جاء فى خبر مكة
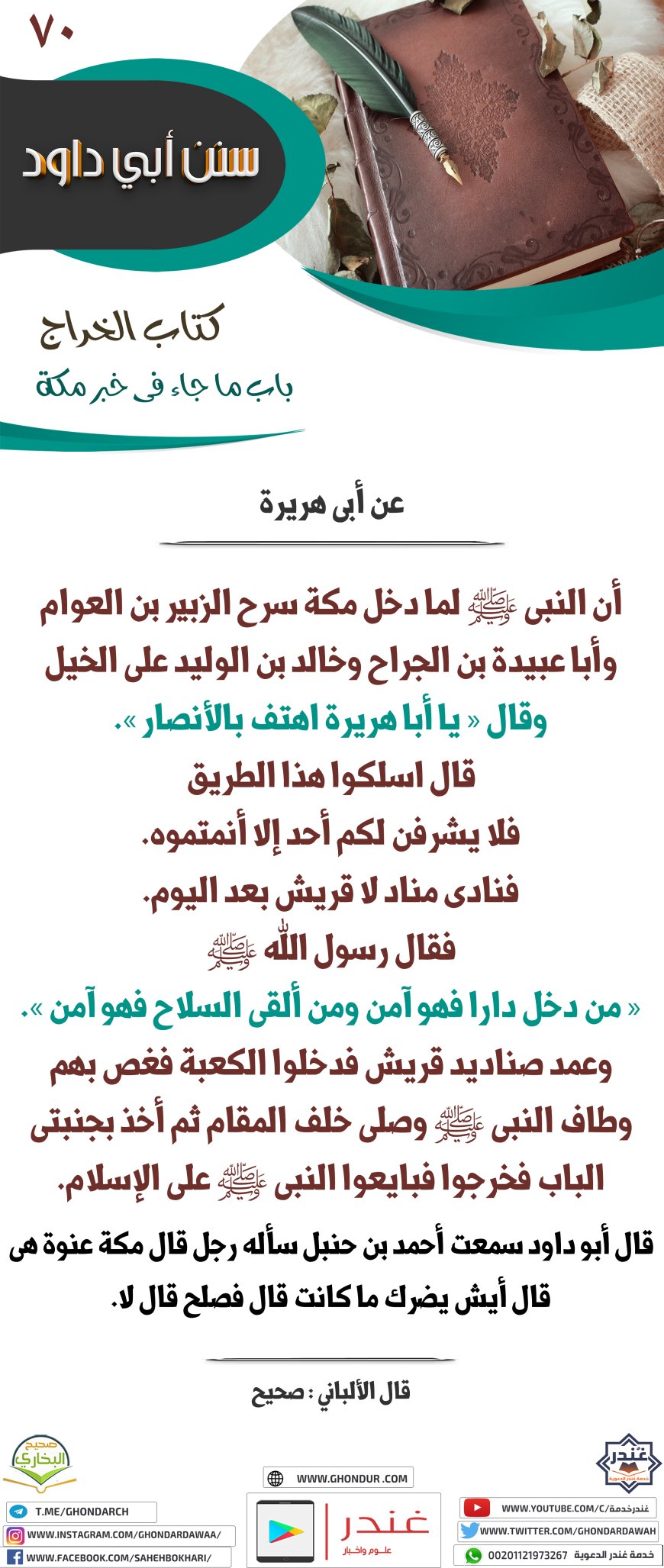
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البنانى عن عبد الله بن رباح الأنصارى عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال « يا أبا هريرة اهتف بالأنصار ». قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فنادى مناد لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من دخل دارا فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ». وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبى -صلى الله عليه وسلم- وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتى الباب فخرجوا فبايعوا النبى -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة هى قال أيش يضرك ما كانت قال فصلح قال لا.

أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار، فقال في حقهم: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9]، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف حقهم وفضلهم، فأوصى بهم صلى الله عليه وسلم، ودعا لهم بالبركة والمغفرة
وفي هذا الحديث يروي التابعي عبد الله بن رباح أنه وجماعة معه وفدوا إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان في هذا الوفد أبو هريرة رضي الله عنه، وكانوا يتناوبون في صنع الطعام لبعضهم، فكان كل رجل منهم يصنع طعاما يوما لأصحابه، وكان هذا اليوم يوم عبد الله بن رباح، وأخبر عبد الله أبا هريرة رضي الله عنه أن اليوم نوبته في إعداد الطعام، فجاؤوا مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى منزل عبد الله وموضع رحله، وهم في حالة انتظار؛ وذلك بسبب عدم نضوج الطعام بعد، فطلب عبد الله من أبي هريرة رضي الله عنه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينضج الطعام، وهذا من الأدب مع الصحابة؛ حيث تلطف معه ليحدثهم، ومن حسن اغتنام الأوقات في تعلم العلم النافع
فأخبرهم أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الذي وقع في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا وقائدا على الجانب الأيمن من الجيش، وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه أميرا وقائدا على الجانب الأيسر من الجيش، وجعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على «البياذقة» وهم الرجالة الذين يمشون على أرجلهم، سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم، وجعل أبا عبيدة أيضا قائدا على من في بطن الوادي، وهم من كانوا بين الجانبين، وهم المسمون بالقلب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يدعو له الأنصار -وهم أهل المدينة- فدعاهم فجاؤوا مسرعين استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم صلى الله عليه وسلم: «هل ترون أوباش قريش؟»، أي: أخلاطهم وجموعهم من قبائل شتى، وفي رواية أخرى لمسلم: «ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا»، والمعنى: أن قريشا استعدت للنبي صلى الله عليه وسلم بحشد من مختلف القبائل والأتباع، على أن يواجهوا بهم جيش المسلمين، فإن كان لهم شيء من النصر، لحقوا بهؤلاء الأتباع مع مقاربة النصر وشاركوهم فيه، وإن انتصر عليهم المسلمون، سلمت قريش للمسلمين الأمر من الخراج والعهد والانقياد لهم، فلا يقتل منهم أحد
فأجابت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم»، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: «انظروا» إلى ما أشير لكم به، إذا لقيتم هؤلاء الأوباش غدا عند القتال، أن تحصدوهم حصدا، والحصد: القطع، وأصله في الزرع، وهو هنا حث على القتل؛ لما كانت الرؤوس والأيدي تقطع فيه، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، فجعل كفه اليمنى كأنها تحصد وتقطع ما قبضت عليه من كفه اليسرى، والغرض من هذه الإشارة الأمر لهم بإيقاع القتل الذريع فيهم كأنهم الزرع المحصود
وقال صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد ومن معه الذين أخذوا أسفل مكة من بطن الوادي: «موعدكم الصفا» أي: إن مكان اجتماعكم معي بعد هذا هو جبل الصفا، وأخذ صلى الله عليه وسلم هو ومن معه أعلى مكة، وهو طريق الحجون، فأطاع الجميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظهر يومئذ لهم أحد من قريش وأتباعها إلا قتلوه، فوقع إلى الأرض وأسكنوه بالقتل كالنائم
ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانتهى طاف بالبيت، ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا، وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا وأحاطوا به، فجاء أبو سفيان -وكان زعيم قريش يومئذ قبل أن يسلم- فقال: «يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش»، أي: أفنيت وأذهب معظمها وجموعها، ولا وجود لقريش بعد هذا؛ وذلك لما رأى من هول الأمر، والغلبة، والقهر، والاستطالة، والاستيلاء عليهم
فأخبر أبو سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن» من القتل، ونودي في الناس بذلك، وفي رواية أبي داود: جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»
وقد قالت الأنصار لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ما فعله مع أهل مكة: «أما الرجل» يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، «فقد أخذته رأفة بعشيرته» يريدون قريشا، «ورغبة في قريته»؛ وذلك لأنهم خافوا أن يؤثر المقام في مكة على المقام بالمدينة معهم، فحملهم شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكراهة مفارقته، أو مفارقة أوطانهم، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلغه بما قالوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، ثم قال لهم: «ألا فما اسمي إذن؟! -وكررها ثلاث مرات-» وكان عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقدمون إجابة على مثل تلك الأسئلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمعرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الأسئلة أن يفهمهم ويعلمهم، والمعنى: إذا أخذتني رغبة في قريتي بمقتضى قولكم، ونقضت بيعتكم على مساكنتكم، ثم قال: «أنا محمد» فهو يحمد بوفاء بيعته مع غيره، وهو أمين لا خائن، يشير بهذا إلى أكمليته صلى الله عليه وسلم في الوجود وإلى اسمه الشريف، وأنه عبد الله ورسوله، وقد هاجر إلى الله وإلى ديار الأنصار لاستيطانها، فلا يتركها ولا يرجع عن هجرته الواقعة لله تعالى، بل هو صلى الله عليه وسلم ملازم لهم، «فالمحيا محياكم، والممات مماتكم»، أي: لا أحيا إلا عندكم، ولا أموت إلا عندكم، فبينوا عذرهم وحلفوا بالله أنهم ما قالوا هذا إلا بخلا بما آتاهم الله من كرامة؛ خشية أن تفوتهم فينالها غيرهم، وشحا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من المدينة إلى بلدته، حرصا منهم على مساكنته، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ورسوله يصدقانهم فيما يقولون، ويقبلان ما ذكروا من اعتذارهم فيما قالوا
وفي الحديث: ما كان السلف عليه من حسن التودد، والمزاورة، والمواصلة، والمكارمة
وفيه: دلالة على البخل بالعلماء والصلحاء، وعدم الرضا بمفارقتهم
وفيه: أنه إذا كان في الجماعة مشهور بالفضل أو بالصلاح، أن يطلب منه العلم
وفيه: بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار
وفيه: بيان ما كان عليه الأنصار من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم

 دعاء محمد السعيد
دعاء محمد السعيد